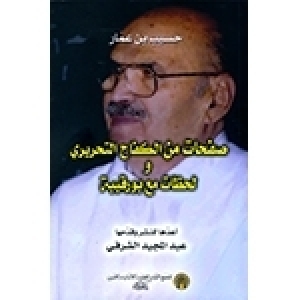"استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة": المآلات المُحْتَمَلَة والتداعيات

(42).jpg) بقلم محمد إبراهيم الحصايري - بعد أن تناولت في الحَلَقَات الثماني السابقة من هذا المقال بالعرض والتحليل محتوى "استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة"، سأبدي، في هذه الحلقة التاسعة والأخيرة، ملاحظاتي عليها، وتوقّعاتي لمآلاتها المُحْتَمَلَة، وبعض ما يمكن أن يكون لها من تداعيات.
بقلم محمد إبراهيم الحصايري - بعد أن تناولت في الحَلَقَات الثماني السابقة من هذا المقال بالعرض والتحليل محتوى "استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة"، سأبدي، في هذه الحلقة التاسعة والأخيرة، ملاحظاتي عليها، وتوقّعاتي لمآلاتها المُحْتَمَلَة، وبعض ما يمكن أن يكون لها من تداعيات.
وفي البداية، أريد أن ألاحظ أن الاستراتيجية تضمّنت جملة من الادعاءات والمزاعم، ومن الحقائق المغيَّبَة أو أنصاف الحقائق.
وقد جاء أوّل هذه الادعاءات والمزاعم في الأسطر الأولى من الكلمة التي صدّر بها الرئيس الأمريكي غريب الأطوار دونالد ترامب الاستراتيجية. فلقد تباهى في هذه الكلمة التي توجّه بها إلى المواطنين الأمريكيين بأنه تمكّن خلال الأشهر التسعة الأولى من ولايته الرئاسية الثانية من "انتشال الولايات المتّحدة والعالم من حافة الكارثة والدّمار"، حيث أن إدارته، "بعد أربع سنوات من الضعف والتطرف والاخفاقات القاتلة، تحركت بسرعة تاريخية وبِعَجَلَةٍ قصوى لاستعادة قوّة أمريكا في الداخل والخارج، وجلب السلام إلى العالم".
ولتأكيد ما يقول، أضاف أنه "على مدى ثمانية أشهر فقط، أنهى ثمانية صراعات مشتعلة بما في ذلك بين كمبوديا وتايلند، وكوسوفو وصربيا، والكونغو ورواندا، وباكستان والهند، وإسرائيل وإيران، ومصر وأثيوبيا، وأرمينيا وأذربيجان، إضافة إلى إنهاء الحرب في غزّة مع عودة جميع الرهائن الأحياء إلى عائلاتهم"...
ولعلّ استمرار إسرائيل، إلى اليوم، في التقتيل والتدمير والتجويع في قطاع غزّة، وفي الاعتداء على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم في الضفة الغربية وفي التوسع على حساب لبنان وسوريا، تكفي للتدليل على مناقضة الواقع لما يدّعيه الرئيس الأمريكي، هذا فضلا عن أن التعبئة التي يقوم بها من أجل العودة إلى ضرب إيران، بل شنّ حرب حقيقية وشاملة عليها، تدحض ما قاله عن "عملية مطرقة منتصف الليل" التي أكد، بكل فخر، أنها "دمّرت قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بالكامل".
ثم إنّ إخفاق الرئيس دونالد ترامب في الفوز بجائزة نوبل للسلام بعنوان سنة 2025 رغم أنه ما انفكّ، منذ عودته إلى البيت الأبيض، يروّج، هو وأنصاره، لصورته كرجل السلام الذي يستحقها عن جدارة، يدلّ على أن لجنة إسناد الجائزة لم تكن "غبيّة" إلى حد الانخداع بحملته الترويجية للجهود التي يزعم أنه بذلها لإطفاء الحرائق الدولية وتسوية النزاعات بين الدول، لا سيّما وقد تبيّن أن تلك "الجهود" لم تكن حبّا في السّلام، وإنما لغايات "ربحيّة" حيث أنه حرص على أن يقرن التسويات بصفقات تُمَكِّنُ الولايات المتحدة من الحصول على مقابل مُجْزٍ مثلما هو الأمر في غزّة، وفي أوكرانيا، وفي الكونغو...
وإذا جئنا، الآن، إلى نصّ الاستراتيجية نفسها فإنّ من أكبر وأكذب الادّعاءات والمزاعم التي تضمّنتها، أنها حاولت الإيهام بأن الولايات المتحدة تضرّرت من "العولمة" التي لم تكن في واقع الأمر إلا "اختراعا أمريكيا" سعت من خلاله إلى "أمركة" العالم حتى تتمكن من الهيمنة عليه سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا هيمنةً أبديّةَ... وقد جَنَتْ منه ما لا تعلمه إلا هي من الفوائد التي لا تحصى ولا تعدّ.
غير أنّ الحاجة إلى تبرير التوجهات الجديدة التي يريد الرئيس دونالد ترامب انتهاجها فرضت على صَاغَة الاستراتيجية تخطئةَ الإدارات السابقة حيث أكّدوا أنّ قادة السياسة الخارجية في الولايات المتحدة أقنعوا أنفسهم، "بعد نهاية الحرب الباردة بأن السيطرة الأمريكية الدائمة على العالم بأكمله تصبّ في مصلحة البلاد"، كما إن النّخب الأمريكية "أخطأت في حساب مدى استعداد الشعب الأمريكي لتحمُّلِ أعباءٍ عالميّةٍ إلى أجَلٍ غير مسمّى بينما لم يَرَ المواطنون أيّ صلة بين الأعباء وبين مصالحهم الوطنية".
وقد يكون المواطن الأمريكي العاديّ لم يَرَ هذه الصلة فعلا، لكن كبرى الشركات الكبرى والمركّبات الصناعية الأمريكية خاصة في مجال الأسلحة رأتها بالتأكيد، واستفادت منها أيّما استفادة.
على أن الاستراتيجية تمعن في ادعاءاتها ومزاعمها حين تقول إن تضرُّرَ الولايات المتحدة من العولمة لم يأتِ فحسب من سوء تقدير نُخَبِها، وإنما أتى أيضا من "سوء استخدامها" من قبل الصّين التي تتهمها بأنها "غدرت" بالولايات المتحدة التي أنشأت "النظام العالمي القائم على القواعد" من أجل بسط هيمنتها على العالم، فإذا بالصين تسخّره لخدمة نهوضها، وتستفيد من الفرص التي أتاحها لتحقّق ما حقّقت من التقدّم، ولتستقطب ما استقطبت من الاستثمارات الدولية بما فيها وعلى رأسها الاستثمارات الأمريكية والغربية حتى تحولت إلى "مصنع العالم" كله...
ثم إنّ الاستراتيجية تشكو، على صعيد آخر، من كلفة الحروب التي شنّتها الولايات المتحدة على العديد من دول العالم (وخاصة على عدد من الدول العربية والإسلامية)، غير أنها تتغافل عن أنها هي التي اختارت، عن عمد وسابق إضمار وإصرار، وأحيانا بذرائع كاذبَة مُخْتَلَقَة، أن تشنّ هذه الحروب التي لا يمكن أن تنكر أنها مكّنتها من نهب ما نهبت من ثروات الدول التي احتلتها وأذلّتها وما تزال، حتى اليوم، تستنزف مقدّراتها وتتصرّف في أموالها، وتملي عليها طريقة حكمها، وكيفية تسيير شؤونها، ولعل أبْلَغَ دليل على ذلك هو مثال العراق الذي صرّح الرئيس دونالد ترامب، في أكثر من مناسبة، بأنه يريد أن يصادر الأموال المودَعَة في المصارف الأمريكية، من قبل مسؤوليه الذين عيّنهم الاحتلال الأمريكي نفسُه، وذلك باعتبارها "ضريبةَ دماءِ الجنود الأمريكيين" الذين قُتِلُوا في الحرب عليه...
إلى ذلك، ومن ناحية أخرى، حرصت الاستراتيجية على تعداد عيوب الاستراتيجيات الأمريكية التي تم إعدادها من قبل الإدارات التي تعاقبت على الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة، فذكرت أنها قصَّرَت، لأنها "كانت عبارة عن قوائم طويلة من الأمنيات أو النتائج المرغوبة، ولم تحدّدْ بوضوح ما نريده، بل اكتفت بعبارات عامّة فضفاضة، وغالبا ما أساءت تقدير ما ينبغي أن نَنْشُدَهُ في الأصل".
وقد عابت على معدّي هذه الاستراتيجيات أنهم بالغوا في تقدير "قدرة أمريكا على تمويل دولة الرعاية والأنظمة التنظيمية والإدارية الضخمة، في الوقت نفسِهِ الذي تموِّلُ فيه مجمعا عسكريا دبلوماسيا استخباراتيا تنمويا واسعا"، وأنهم راهنوا "بشكل خاطئ مدمّر على العولمة وما سمّيَ (التجارة الحرة) الأمر الذي أدّى الى تفريغ الطبقة الوسطى والقاعدة الصناعية التي تقوم عليها الهيمنة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية"، كما إنهم سمحوا "للحلفاء والشركاء بنقل تكاليف دفاعهم إلى الشعب الأمريكي وأحيانا بجرّ الولايات المتحدة إلى صراعات ومنافسات لم تكن في مصلحتها ولا تخدم أمنها ولا يريدها الشعب الأمريكي"... ثم إنّهم، علاوة على كل ذلك "ربطوا التوجّه السياسي الأمريكي بشبكة من المؤسسات الدولية، بعضُها يقوم على عداء صريح لأمريكا، والعديد منها يقوم على نزعة عابرة للحدود تسعى بشكل مباشر الى تذويب سيادة الدول الفردية".
ومعنى ذلك، باختصار، كما تقول الاستراتيجية أن قادة الولايات المتحدة الذين اعتمدوا على هذه الاستراتيجيات "لم يكتفوا بالسعي وراء هدف غير مرغوب ومستحيل التحقيق بل إنهم، أثناء ذلك، قوّضوا الأدوات والقدرات الأساسية اللازمة لتحقيق أيّ هدف: أي الطبيعة الجوهرية للأمة الأمريكية التي بُنِيَتْ عليها قوّتُها وثروتُها وقيمُها الأخلاقية"...
وخلاصة القول أنّ هذه الاستراتيجيات كانت "السببَ في كلّ المشاكل والصراعات والتراجعات التي تعاني منها قوّة الولايات المتحدة ونفوذها وتنافسيتها الاقتصادية".
والغريب في الأمر أن الاستراتيجية لا تشعر، بعد ذلك، بأي تناقض بين ما عدّدته من عيوب هذه الاستراتيجيات، وبين ما استعرضته لاحقا من ركائز قوة الولايات المتحدة التي تصفها بأنها "لا تضاهيها أيّ قوة أخرى في العالم"...
إن هذه الركائز تتمثل في جملة "المزايا التي تتمتع بها الولايات المتّحدة عالميا"، وهي بقطع النظر عن موقعها الجغرافي الذي تُحْسَد عليه، تتمتع بنظامٍ سياسيٍّ "ما يزال قادرا على التصحيح والتعديل عند الحاجة"، وبوفرةِ ما تَمْلِكُهُ من أصول وموارد، كما إنها تتوفّر على أكبر اقتصاد في العالم وأكثره ابتكارا، وهو اقتصاد يولّد ثروة يمكن للولايات المتحدة استثمارها في مصالحها الاستراتيجية ويمنحها نفوذا على الدول التي تريد الوصول إلى أسواقها، وهي إلى ذلك تمتلك نظاما ماليا وأسواقا رأسمالية رائدة في العالم، ومن ذلك احتفاظ الدولار بوضعه كعملة احتياطية دولية، كما تمتلك قطاعَ تكنولوجيا هو الأكثر تقدما وابتكارا وربحيَّة في العالم، وهو قطاع يدعم اقتصادها ويوفِّرُ ميزة نوعية لجيشها، كما يعزّز نفوذها العالمي، لا سيّما وأنها تريد أن تضمن أن تظل التكنولوجيا الأمريكية والمعايير الأمريكية، خصوصا في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية والحوسبة الكمّية، هي التي تقود العالم إلى الأمام.
ثُمَّ إن الولايات المتحدة، قبل كل ذلك وبعده، "تملك أقوى وأقدر قوّة عسكرية في العالم كما تتوفر على شبكة واسعة من التحالفات تشمل حلفاء بمعاهدات وشركاء في أهم المناطق الاستراتيجية في العالم" كما إنها "تملك قوّة ناعمة لا مثيل لها ونفوذا ثقافيا عالميا".
إن جميع هذه المزايا التي تتضارب مع ما قالته الاستراتيجية عن عيوب استراتيجيات الإدارات السابقة، هي المزايا التي يعوّل الرئيس دونالد ترامب عليها في تحقيق ما يحرّكه وما يحرك الولايات المتحدة من أطماع أنانية نَهِمَة جَشِعَة تردّدت في كل أثناء الاستراتيجية وثناياها...
غير أن المقاربَة التي فصّلت الاستراتيجية الحديث عن مكوّناتها، والتي بدأ، بل استأنف الرئيس دونالد ترامب العمل بها منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية، تطرح عدة إشكاليات لأنّها قائمة، فيما أرى، على خلق "حالةِ استنفَارٍ مُنَفِّرَة" حتى بالنسبة إلى الحلفاء والشركاء، وهو ما يظهر فيما يلي:
• أنّ هذه المقاربة تنيط بعهدة "القوة الناعمة" الأمريكية دورا ستعتمد في الاضطلاع به على "مبادئ" هي، في الواقع، أقرب إلى خليط من النزعات المصلحية الضيّقة، ومن الأهداف بل الأهواء الأنانية الجامحة التي يريد الرئيس الأمريكي غريب الأطوار دونالد ترامب إرضاءها من خلال إعادة "هندسة" طريقة تعامل الولايات المتحدة مع العالم.
• أنّها ستستند إلى سياسة خارجية أمريكية وصفتها الاستراتيجية بأنها "سياسة عمليّة من دون أن تكون (براغماتية) بالمعنى النظري، وواقعية من دون أن تكون (واقعية) كمذهب فكري، ومبدئية من دون أن تكون (مثالية)، وقويّة من دون أن تكون (متشدّدة)، ومتحفظة من دون أن تكون (حمائية)"، ومثل هذه السياسة، كما أسْلَفْتُ القولَ، لا يمكن أن تكون إلا سياسة "هجينة" وغير قابلة للتصنيف، لاسيما وأنها، كما جاء في الاستراتيجية "لا تقوم على إيديولوجيا سياسية تقليدية بل تقوم، قبل كل شيء، على ما يخدم مصلحة أمريكا أو بكلمتين (أمريكا أولا)"، هذا الشعار الذي يعني أنّ كفّة مصلحة الولايات المتحدة ترجح على كفّة مصالح العالم بأسره.
• أنّها تستخدم الضغط الاقتصادي بكافة أشكاله وعلى الجميع، سواء كانوا حلفاءَ وشركاءَ أو منافسين وخصومًا، فمن أجل تحقيق التوازن في المبادلات التجارية الأمريكية مع العالم، والسيطرة على سلاسل الإمداد، وإعادة توطين التصنيع، ودعم الاقتصاد الأمريكي بجذب الاستثمارات، وفي نفس الوقت منْعِها من الوصول إلى المنافسين والخصوم عن طريق العقوبات، ما فتئ الرئيس دونالد ترامب يتلاعب بالرسوم الجمركية والأداءات التي يهدّد بفرضها أو يفرضها فعلا على التوريد والتصدير، كما يمارس شتى أنواع الضغوط على "الدول الثرية" لكي تستثمر في الولايات المتحدة، وتُحْجِمَ عن التعامل مع منافسيها وخصومها.
• أنّها لا تتورّع عن استغلال مسألة مكافحة الإرهاب والتطرف، والهجرة غير النظامية، وتهريب المخدّرات، والجريمة المنظمة، كأدوات ضغط ومساومة لاسيّما في التعامل مع بلدان "نصف الكرة الغربي" وفي منطقة الشرق الأوسط، والقارة الإفريقية، وحتى في أوروبا "المهدّدة بالاندثار حضاريًّا"، وذلك من أجل الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من موارد هذه البلدان ومعادنها النادرة، وحرمان الدول والقوى الأخرى من الوصول إليها.
• أنّها تتعامل مع ظاهرة الهجرة بصورة عامة، والهجرة غير النظامية بصورة خاصة بـ"شراسة" منقطعة النظير، وقد تجلت شراستها الصادمة في "خشونة" الإجراءات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب لمكافحتها، منذ الأيام الأولى لولايته الرئاسية الثانية.
• أنّها، في مقابل كل ذلك، قوّضت برنامج المساعدات الخارجية الأمريكية للدول الفقيرة والنامية، حيث دشّن الرئيس دونالد ترامب، ولايته الثانية بتعليق هذا البرنامج الذي شيطنه وأمر بإعادة النظر فيه، جملة وتفصيلا.
• أنّها تَعِدُ وعدًا، سرعان ما تبين أنه كاذب، بأن الولايات المتحدة التي بدأت تشعر بضرورة مراجعة أسلوب تعاملها مع الدول الأخرى وتغييره، تتوجّه نحو التخلي عن هَوَسِها المَرَضِيِّ بعولمة "نموذجها الحضاري" وبفرض الديمقراطية وحقوق الانسان، كما تراها هي، على جميع دول العالم وشعوبه.
ورغم أن الاستراتيجية تقِرُّ بأن "الالتزام الصّارم بعدم التدخل ليس ممكنا دائما بالنسبة إلى دولة مثل الولايات المتحدة ذات مصالح واسعة ومتنوعة"، فإنّها روّجت لهذا التوجه الطارئ على السياسة الأمريكية، غير أن الأحداث أثبتت أنّه لم يأتِ عن قناعة، وإنما هو أشبه بـ"خطوة تكتيكية" تحاول الولايات المتحدة من خلاله أن تقلّد الصين التي لا تقرن تعاونها مع الدول الأخرى بأيّ شروط سياسية، وليس أدلَّ على ذلك من تدخلها السافر في فنزويلا، والحرب التي تعد لشنّها على إيران، والتهديدات المستمرة التي توجهها إلى كولمبيا وكوبا وغيرهما من دول أمريكا اللاتينية، والضغوط التي تمارسها، حاليا، على العراق حتى فيما يتعلق باختيار رئيس حكومته...
• أنّها، على صعيد آخر، تشكّك في العمل متعدّد الأطراف، وتقلل من شأن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بصفة عامة، حيث أن الاستراتيجية تنصّ، بكل وضوح، على "أن الولايات المتحدة تدافع عن الحقوق السيادية للأمم في مواجهة تدخلات المنظمات العابرة للحدود التي تقوض السيادة"، وتشدد على أنّها "ستحدّد مسارها الخاص في العالم، وترسم مصيرها بنفسها بعيدا عن أيّ تدخل أجنبي"، وهي لذلك "ستقوم، من دون اعتذار، بحماية سيادتها. ويشمل ذلك منع تآكلها على يد المنظمات الدولية والعابرة للحدود"...
ومعلوم في هذا النطاق أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعلنت حتى الآن عن الانسحاب من 66 منظمة واتفاقية دولية، (31 هيكلاً تابعاً للأمم المتحدة و35 منظمة أخرى) وذلك بدعوى إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية بما ينسجم مع شعار "أمريكا أولاً"، ويركّز على المصالح الوطنية، ويقلّص الإهدار في تمويل منظمات لا تخدم المصالح الأمريكية وتخضع لإيديولوجيات مناوئة، وهي إلى ذلك "تقيّد السيادة" و"تثقل كاهل الاقتصاد" الأمريكي (بلغت قيمة المستحقّات المتراكمة على الولايات المتحدة أكثر من 4 مليارات دولار).
ومن نافلة القول في هذا السياق أنّ متاعب منظمة الأمم المتحدة التي تعاني، أصلاً، من شحّ مواردها بسبب امتناع الولايات المتحدة من تسديد مساهمتها في ميزانيتها، ستزداد تفاقما نتيجة إنشاء "مجلس السلام" الذي يعقد اليوم الخميس 19 فيفري 2026 أولى جلساته، والذي يبدو أن الرئيس دونالد ترامب أسّسه لمنافستها على الاضطلاع بالمهام المناطة بعهدتها بموجب الميثاق.
• أنّها تتضمّن توجُّها خطيرا آخر حيث أن "البرنامج المحلي القويّ" الذي وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم على إطلاق العنان لقدرة الولايات المتحدة الهائلة على إنتاج الطاقة كأولوية استراتيجية، وذلك من أجل استعادة الهيمنة الأمريكية في هذا المجال (الذي يشمل النفط والغاز والفحم والطاقة النووية).
وتكمن خطورة هذا التوجّه في أنّ له بُعْدًا كونيّا، حيث أن الولايات المتحدة انسحبت من "اتفاقية باريس للمناخ" بذريعة رفضها لإيديولوجيات "التغير المناخي" و"صفر انبعاثات" لأنها كما تزعم "ألحقت ضررا كبيرا بأوروبا، وتهدّد الولايات المتحدة، وتقدِّمُ دعما غير مباشر لخصومها"، ومن المؤكَّد أن هذا الانسحاب يضرّ بالتعاون الدولي في ملفات البيئة والتنمية وحقوق الإنسان، ومن المتوقّع أن تكون الدول الإفريقية على رأس المتضررين من ذلك، خاصة وأن العديد منها يعتمد على الدعم الدولي في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي...
وغنيٌّ عن البيان أن جملة هذه الإشكاليات ستلقي بظلالها على إمكانية تطبيق الاستراتيجية التي يرى العديد من الملاحظين أنها ستكون رهينة عدة عوامل ورهاناتٍ داخليّةٍ وخارجيّةٍ هيكليّةٍ لعل أهمها التالية:
• أولا وعلى الصعيد الداخلي الأمريكي، تجب الملاحظة أنّ الخزينة الأمريكية باتت مرهَقَة بالعجز والدين الداخلي والخارجي (37 تريليون دولار سنة 2025). ومعنى ذلك أن التوجّهات الامريكية الجديدة لم تأت كخيارات إرادية وإنما كخيارات اضطرارية، فالولايات المتحدة لم تَعُدْ، على ما يبدو، قادرة على أن "تحشر أنفها" في كل قضايا العالم ومشاكله، وهو ما تقرّ به الاستراتيجية عندما تعلن بكل وضوح أن الولايات المتحدة "لا يمكنها تحمّلُ أن تكون متيقِّظَةً وبالدرجة نفسها لكل منطقة ولكل مشكلة في العالم".
ومما يؤكّد ذلك أيضا، إلحاح الاستراتيجية والرئيس دونالد ترامب، باستمرار، على ضرورة "تقاسم الأعباء" بين الولايات المتحدة وبين حلفائها وشركائها، كأولوية مطلقة، فلقد أعلنت الاستراتيجية، بكل صراحة ودون أيّ مواربة، "أنّ زمن تحمُّلِ الولايات المتحدة لعبء النظام العالمي بأكمله انتهى"، بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك حين قالت إنّ الولايات المتحدة لم تعُدْ تريد والأقرب إلى الظن، فيما أرى، أنها لم تَعُدْ تستطيع الاضطلاع بدور الجبّار "أطلس" الذي تقول الأساطير الإغريقية، إن الآلهة كلَّفَتْه بحمل قبَّة السَّماء على كتفيه.
وما من ريب أن تشبيهَ الولايات المتحدة بـالجبّار "أطلس" يشكّل اعترافا ضمنيا بأنها باتت منهَكَةً، خائرةَ القوى، إلى حدِّ أنّها لم تعد قادرة على أن تحمل على كتفيها النظام العالمي الأحادي الذي قامت بإنشائه، بمحض إرادتها وتوهُّمًا منها باّن التاريخ بلغ نهايته بانتهاء الحرب الباردة، وذلك طمعا في الهيمنة على العالم هيمنةً أبديّة.
• أنّ "تحمُّلَ الأعباء" الذي تريده الولايات المتحدة لا يتعلق فحسب بالمجال العسكري سواء في نطاق حلف شمال الأطلسي أو غيره من الأحلاف، بل يمتد إلى الجانب الاقتصادي، فعندما تطرقت الاستراتيجية إلى التفوّق الذي أحرزته الشركات الصينية المدعومة والموجَّهَة من الدولة في بناء البنى التحتية المادية والرقمية في بلدان الشركاء التجاريين للصين التي أعادت توظيف ما يقارب 1.3 تريليون دولار من فوائضها التجارية على شكل قروض في هذه البلدان، أكدت أن تدارك هذا الأمر يتطلّب وضع وتنفيذ خطة مشتركة لما يسمى بـ"الجنوب العالمي" من قبل الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها الذين يمتلكون معا موارد هائلة (تلاحظ الاستراتيجية في هذا الصدد أن أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها تمتلك أصولا مالية أجنبية صافية تبلغ 7 تريليونات دولار. كما إن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنوك الإنمائية متعددة الأطراف تمتلك أصولا مجتمعة تبلغ 1.5 تريليون دولار).
• من ناحية أخرى تؤكد الاستراتيجية على أنّ الولايات المتحدة تحتاج إلى "الحفاظ على قوَّتها الناعمة التي لا مثيل لها، والتي من خلالها تمارس نفوذا إيجابيا في مختلف أنحاء العالم بما يخدم مصالحها، ومما سيساعد على ذلك استعادة وتجديد الصحة الروحية والثقافية لأمريكا".
وبقطع النظر عن أنّ عملية "استعادة وتجديد الصحة الروحية والثقافية لأمريكا"، ستحتاج إلى وقت طويل، وأنّها، حتى إن تمّت فعلا، لا يمكن أن تعوّض القوة الناعمة الأمريكية عن تجريدها من استخدامات "برنامج المساعدات الخارجية" المتنوّعة، فإنّ الحديث عنها جاء في أسوإ توقيت ممكن، لأنّه تزامن مع وقائع تؤشر إلى تدهورها بشكل غير مسبوق، مثلما يدل على ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، الدعم الأمريكي المطلق لحرب الإبادة المتوحشة التي تواصل إسرائيل شنّها على قطاع غزة، والشراسة منقطعة النظير التي تتم بها معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية في الولايات المتحدة، والزلزال الذي أحدثته عودة فضيحة إبستين إلى الطُّفُوِّ على السطح، خاصة مع الكشف عن جانب هامّ من ملفّاتها في الآونة الأخيرة...
• ثم إنّ المحلّلين يتوقّعون أن تصطدم الاستراتيجية بالتحديات والتعقيدات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها الساحة الداخلية الأمريكية، وهو ما يمكن أن يعرقل المسار الذي ينتهجه الرئيس دونالد ترامب انتهاجه...
• ثانيا وعلى الصعيد الخارجي، لا بد من الملاحظة، في البداية، أنّ الاستراتيجية تتضمن جملة من التوجهات التي تدخل في باب "اللامعقول السياسي والأخلاقي"، ومن ذلك أنها لا تشعر بأيّ حرج ولا أيّ تناقض عندما تنتقد "الممارسات الاقتصادية الافتراسية" التي تأتيها القوى المنافسة للولايات المتحدة، وبالتحديد الصين، لكنها في المقابل تعتبر أن من حقّ واشنطن أن تؤمّن وأن توسّع الوصول إلى سلاسل الإمداد، وإلى المعادن والمواد الحيوية، وخاصة أن تواجه ممارسات منافسيها بممارسات أشدّ افتراسا، وليس أدل على ذلك من أنها تبشر العالم بأن "أجهزة الاستخبارات ستقوم بمراقبة سلاسل الإمداد الرئيسية والتطورات التكنولوجية حول العالم لضمان فهم المخاطر والثغرات التي قد تُعرِّض أمن وازدهار الولايات المتحدة للخطر".
ونقس الملاحظة تنطبق على تأكيد الولايات المتحدة التي تبيح لنفسها احتكارَ التحكّم في "نصف الكرة الغربي" وتحرِّمُ على كافة القوى والدول الأخرى مجرَّد الاقتراب منه، على أنها تريد من أجل "إيقاف وعكس مسار الضرر المستمر الذي تلحقه الجهات الأجنبية بالاقتصاد الأمريكي" أن تضمن "الحفاظ على حرية وانفتاح منطقة الهندي-الهادئ وصون الملاحة في جميع الممرات البحرية الحيوية" وذلك بغية "ضمان وجود سلاسل إمداد آمنة وموثوقة، وتوفير الوصول إلى المواد الاستراتيجية الأساسية (أو ما يسمى بالمواد الحرجة)".
• إلى ذلك تؤكد الاستراتيجية أنّ الولايات المتحدة التي "تتمتّع بأقوى الأسواق المالية وأسواق رأس المال في العالم، وهي ركائز أساسية للنفوذ الأمريكي تمنح صانعي السياسات أدوات قويّة لتعزيز أولويات الأمن القومي"، ستعمل على الحفاظ على هيمنة القطاع المالي الأمريكي وعلى تقويتها، لأنّها تعلم أنّ "هذا التفوّق لا يمكن اعتباره أمرًا مسلّما به"، خاصة في خضمّ سعي مجموعة "البريكس الموسّعة" والعديد من دول "الجنوب العالمي" بشكل حثيث ومتصاعد إلى فكّ الارتباط مع الدولار الأمريكي واستبداله، في معاملاتها التجارية، بالعملات الوطنية.
• رغم أن الاستراتيجية تؤكد، عند الحديث عن القارّة الآسيوية، أنّ الولايات المتحدة تهدف في الفترة القادمة، إلى "منع الصراع مع الصين" فإنّها تُشْفِع هذا التأكيد بأنّ تحقيق هذا الهدف يتطلب، حسب قولها "اعتماد اليقظة في منطقة الهندي-الهادئ وإحياء قاعدة الصناعات الدفاعية، وزيادة الاستثمار العسكري من جانبها ومن جانب حلفائها وشركائها (الهند واليابان وكوريا الجنوبية والفيليبين وأستراليا وغيرها)، إضافة إلى الانتصار في المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية على المدى الطويل".
إنّ هذه المتطلبات هي متطلبات الاستعداد للحرب لا لتجنّبها، وما من شك، كما سبق أن قلت في الحلقة الخامسة من هذا المقال، أن تلبيتها تبقى رهينة ثلاثة عوامل كبرى هي أولا، مدى قدرة الولايات المتحدة المرهَقَة بالديون والتي فقدت عَظَمَتَها وتريد أن تستردّها، على الوفاء بمستلزمات الاستمرار في الحفاظ على تفوّقها الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي على الصين، وثانيا، مدى استعداد الحلفاء والشركاء للاستجابة لمطالب الرئيس الأمريكي الذي يريد أن يلقي بأعباء المواجهة الثقيلة المحتمَلَة مع الصين على عاتق بلدانهم وشعوبهم، وثالثا، مدى صلابة موقف الصين ذات القدرات المتنامية باطراد، والتي ستعمل، يقينا وفي صمت، من أجل إحباط الأهداف الأمريكية وإجهاضها بكل ما لديها من قوة حاليّا، وما سيكون لها من قوة مستقبلا لاسيما وأنها ستجتهد، هي أيضا، في استقطاب دعم أصدقائها الذين يزدادون عددًا سواء في إطار مجموعة "البريكس الموسّعة" أو في إطار ما يسمى بـ"الجنوب العالمي"، وذلك بفعلِ وبفضلِ السياسات الفظة الغليظة التي ما فتئ الرئيس الأمريكي غريب الأطوار دونالد ترامب يتعامل بها مع معظم دول العالم، بما فيها الدول الحليفة والشريكة.
• في نفس هذا السياق، تجدر الملاحظة أنّ وزارة الحرب الأمريكية تؤكد في استراتيجيتها لسنة 2026، على أنها ستعمل على "الحفاظ على توازن مُوَاتٍ للقوة العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وليس ذلك بهدف الهيمنة على الصين، ولا لخنقها أو إذلالها. بل إن الهدف أكثر تحديدًا ومعقولية من ذلك بكثير: وهو ببساطة ضمان ألا تتمكن الصين، ولا أي جهة أخرى، من الهيمنة على الولايات المتحدة أو حلفائها".
وبكل الغطرسة الأمريكية المعهودة، تعتبر وزارة الحرب أنّ هذا الهدف "لا يتطلب تغيير النظام أو صراعًا وجوديًا من أيّ نوع. بل إن سلامًا لائقًا، بشروط مواتية للأمريكيين ويمكن للصين أيضًا قبولها والتعايش معها، يظل ممكنًا"، غير أنها، من منطلق أن الصين "تُعدّ بالفعل ثانيَ أقوى دولة في العالم" وأنّ "قوتها آخذة في الازدياد"، لاسيما وأنها "أنفقت مبالغ طائلة على جيش التحرير الشعبي خلال السنوات الأخيرة" وهي "ما تزال قادرة على إنفاق المزيد على قواتها العسكرية"، تنَبه إلى أنها "ستعمل على ضمان أن يكون الرئيس ترامب قادرًا دائمًا على التفاوض من موقع قوة من أجل الحفاظ على السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"... كما ستضمن أن تكون القوة المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة "قادرة دائمًا على تنفيذ ضربات وعمليات مدمّرة ضد أهداف في أيّ مكان في العالم، بما في ذلك مباشرة من داخل الوطن الأمريكي، وبذلك تزوّد الرئيس بمرونة تشغيلية وقدرة مناورة لا مثيل لهما"، كما "توضّح أنّ أي محاولة للعدوان على المصالح الأمريكية ستفشل، وبالتالي فهي لا تستحق المحاولة من الأساس. وهذا هو جوهر الردع عبر الدفاع بالإنكار (Denial Defense)".
• إلى ذلك، ستسعى الولايات المتحدة إلى مواجهة تنامي النفوذ الصيني والروسي في إفريقيا حيث باتت الصين أكبر شريك تجاري للقارة، بينما باتت روسيا أكبر مصدّري الأسلحة إليها، وذلك للحفاظ على نفوذها الجيوسياسي على الساحة الإفريقية، غير أنّ نظرة الرئيس دونالد ترامب إلى إفريقيا والأسلوب الذي اعتاد أن يعامل به القادة الأفارقة، والمقاربة الجديدة للعلاقات الأمريكية الإفريقية، عناصرُ ليس من شأنها أن تشجّع الدول الإفريقية على الاستمرار في المراهنة على الخيار الأمريكي.
وقد لوحظ، مثلا، أن رئيس الغابون بريس أوليغي أنغيما خاطب الرئيس الأمريكي خلال القمة التي عقدها في البيت الأبيض مع خمسة قادة أفارقة في جويلية 2025، فقال إن "إفريقيا ليست فقيرة وإنما تحتاج إلى شراكات مربحة للجميع، وهو ما يمكن أن توفره أمريكا كما قد يوفّره غيرُهَا"، وكان في ذلك تذكيرٌ بأن للولايات المتحدة منافسين في إفريقيا، وعلى رأسهم الصين.
ومن المرجّح، في نظر المحلّلين، أن تدفع سياسة "تجفيف" المساعدات الأمريكية للدول الإفريقية وفرض الرسوم الجمركية على صادراتها، وطرد مهاجريها وتقييد دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، هذه الدول إلى تغيير اصطفافاتها بالابتعاد عن الولايات المتحدة، والاقتراب أكثر من الصين التي تتبع سياسة مناقضة للسياسة الأمريكية القسريّة، والتي أفادت وسائل إعلامها الحكومية يوم السبت 14 فيفري 2026، أنها ستُعْفي، اعتبارا من أول ماي المقبل، وارداتها من 53 دولة إفريقية من الرسوم الجمركية.
وإلى ذلك، فإنه ليس من المؤكد أن تنجح الولايات المتحدة بما تمارسه من ضغوط سياسية على الدول الإفريقية، وبما تقوم به من تأليب على الصين، وما تدعو إليه من مراجعة للأسس التي قامت عليها اتفاقيات التعاون الصيني الإفريقي، في عزل الصين وعرقلة حصولها على المعادن النادرة والسعي إلى إخراجها بل طردها من الدول التي تتعاون معها في هذا المجال الذي يعد من أهم مجالات التسابق التجاري والصناعي بين الجانبين الأمريكي والصيني.
• فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية التي حدّدتها الاستراتيجية في منع أيّ قوة معادية للولايات المتحدة من الهيمنة عليها، وعلى إمداداتها من النفط والغاز، وعلى الممرات البحرية التي تمر منها الإمدادات، وفي ضمان ألا تكون حاضنة أو مصدراً للإرهاب ضد المصالح الأمريكية وأن تظل إسرائيل آمنة.
وفي المقابل تَعِدُ الولايات المتحدة بأنها ستتعامل بواقعية مرنة مع المنطقة من خلال التخلي عن التدخل في شؤون بلدانها الداخلية، إلا عند الضرورة.
غير أنّ ما يثير القلق في هذه الأهداف هو النظرة الجامحة التي ينظر بها الرئيس الأمريكي إلى المنطقة حيث أنه يتوهّم أنّه، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حقق السلام الدائم المنشود في المنطقة كلِّها، وأنّ المنطقةَ كلَّها باتت مهيأة للدخول في مرحلة جديدة تتحول فيها إلى "منطقة شراكة وصداقة واستثمار" وإلى "مصدرٍ ووجهةٍ متزايدة للاستثمارات الدولية وفي قطاعات تتجاوز النفط والغاز بما في ذلك الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الدفاعية"، وهو، دون شكّ، أمرٌ مشكوك فيه، لاسيّما في ظل ما ينوي القيام به في قطاع غزّة الذي سيتقاسم الاستيلاء عليه مع إسرائيل ليجعل منه "ريفييرا الشرق الأوسط"، وليحقّق فيه جملة من المآرب الأخرى التي ما تزال خفية الآن، ولكن الأيام ستكشف عنها...
وغني عن البيان أن ما يحدث الآن في الشرق الأوسط يحمل في طياته بذور تفجّر جديد، قد لا يتأخر كثيرا، للأوضاع في فلسطين خصوصا، وفي المنطقة ككل عموما، وذلك لأن الولايات المتحدة ورئيسها غريب الأطوار يتغافلان عن المشكلات الحقيقية التي ما فتئ الشرق الأوسط يعاني منها والتي ستتفاقم مستقبلا في ظل تغوّل إسرائيل ودعم الولايات المتحدة المطلق لتغوّلها، سواء عسكريّا بمدها بأحدث وأفتك أنواع الأسلحة الأمريكية، أو سياسيّا بمنع محاسبتها على جرائمها البشعة، وبفرض تطبيع العلاقات معها على المزيد من الدول العربية والاسلامية.
• من المفارقات المثيرة التي تضمّنتها الاستراتيجية أنّ الولايات المتحدة أعلنت أنها ستكفّ عن استخدام أسلوب الضغط على دول الشرق الأوسط لحملها على التخلي عن تقاليدها وأشكال حكمها التاريخية، تتجه نحو استخدام هذا الأسلوب مع أوروبا حليفتها التقليدية الكبرى التي تتهمها بتقييد حرية التعبير، وقمع المعارضة السياسية، وتؤكد أنها ستعمل على حماية حضارتها وهويتها من الاندثار بسبب فشل السياسات التي تنتهجها في التعامل مع ظاهرة الهجرة الجماعية، وما تنطوي عليه من مخاطر على الديموغرافيا الأوروبية، وعلى النموذج الحضاري والاجتماعي الأوروبي، وذلك من خلال دعم "الأحزاب الوطنية الصاعدة" (المقصود بذلك الأحزاب القومية واليمينية المتطرفة) التي تعارض سياسات بروكسل التقليدية، وتتقاطع توجهاتها مع توجهات الولايات المتحدة.
ومن الطبيعي أن تقابل أوروبا هذا التوجّه الأمريكي بالكثير من الامتعاض والاستياء لاسيما وأنه يندرج في إطار مُتَوالِيَةٍ من المواقف والتحركات الأمريكية التي تكاد تكون "عدائية" إزاءها، حيث أنّ الولايات المتحدة استخدمت سلاح الرسوم الجمركية ضد أصدقائها الأوربيين مثلما استخدمته ضد خصومها ومنافسيها، كما إنها فرضت عليهم التعهّد برفع نسبة إنفاقهم العسكري إلى 5 بالمائة من انتاجهم الإجمالي السنوي، ثم أعلنت عن تقليص انخراطها العسكري المباشر في القارة الأوروبية، ودعت القارة إلى تحمّل مسؤولية الدفاع عن نفسها بنفسها، وهو ما يضع حاضر حلف شمال الأطلسي ومستقبله موضع تساؤل، وإلى ذلك دأبت على انتقاد الموقف الأوروبي من روسيا ومن الحرب في أوكرانيا، والأدهى من كل ذلك أنها ما فتئت تهدد بالاستيلاء على غرينلاند، بالقوة إن لزم الأمر، لأن هذه الجزيرة، كما تقول، ضرورة من ضرورات الأمن القومي الأمريكي...
• على صعيد أشمل، تجدر الملاحظة أن ذروة التحدّي الأمريكي للعالم بأسره، تتجلى في أنّ الولايات المتحدة التي ما انفكت تهدّد وتتوعد الجميع بما في ذلك حلفاءها وشركاءها، تقول من جهة إنها تريد تحقيق "توازن القوى" في العالم، ومن جهة أخرى تعلن، بكل عُلُوٍّ وَغُلُوّ،ٍ أنها "لن تسمح لأي دولة بأن تصبح مهيمِنَة إلى درجة تمكّنها من تهديد مصالحها"، وهي لتحقيق هذه الغاية "ستعمل مع الحلفاء والشركاء للحفاظ على توازنات القوى العالمية والإقليمية بهدف منع ظهور خصوم مهيمِنِين".
ومن أغرب ما جاء في تبرير هذه الدعوة إلى ما سمَّيْتُه "حالة استنفار مُنَفِّر"، أن الولايات المتحدة التي تؤكد استراتيجية أمنها القومي على أنها ينبغي أن تبقى "أعظم وأنجح دولة في تاريخ البشرية وموطن الحرية على الأرض"، تزعم أنها "ترفض الهيمنة العالمية لنفسها" ولذلك "فإنّ عليها أيضا منع الهيمنة العالمية وفي بعض الحالات حتى الإقليمية من قبل الآخرين".
ولا تكتفي الاستراتيجية بذلك، بل إنها تشير، في نوع من التهديد المبطَّن، إلى أن "هذا لا يعني إهدار الدم والمال لمحاصرة نفوذ كل القوى الكبرى أو المتوسطة في العالم. فحقيقة أن الدول الأكبر والأغنى والأقوى تمتلك نفوذا أكبر هي حقيقة أزلية في العلاقات الدولية، وهذه الحقيقة تتطلب في بعض الأحيان العمل مع الشركاء لإحباط طموحات تهدّد مصالحنا المشتركة"، ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة مصمِّمَة على أن تحافظ على تفوّقها على جميع دول العالم، على جميع المستويات، وعلى أن تؤمِّن أسباب هيمنتها على الساحة الدولية بكل الوسائل الممكنة، وذلك من خلال العمل أوّلا بشعار "أمريكا أولا" الذي يعنى، مرة أخرى، أن كفّة مصلحة الولايات المتحدة ترجح على كفة مصالح كافة الدول الأخرى، وثانيا بشعار "فرض السلام من خلال القوة" الذي يعني أن تمتلك الولايات المتحدة من القوة ما يجعلها "محترمة" وبالتالي قادرة على أن "تصنع" أو في الحقيقة أن تفرض السلام الأمريكي في أنحاء العالم.
وخلاصة القول في خاتمة هذا المقال، هي أنَّ ما يُسْتَشَفُّ من خلال "استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة" هو أن الولايات المتحدة بدأت تخرج من "حالة الإنكار" التي كانت تتمترس خلفها، إلى "حالة الاعتراف" بأنها لم تعُدْ القوة العظمى التي تستطيع أن تهيمن على العالم، وأن تتحكّم في شؤونه بشكل أحادي، مثلما كانت تفعل إثرَ انتهاء الحرب الباردة الذي أدخلها في "حالة انتشاء" جعلتها تتوهّم أن التاريخ بلغ نهايته، وأن انتصارها نهائي وأبديّ.
ولعلّ الرئيس الأمريكي غريب الأطوار دونالد ترامب ينزع، من رفع شعار "إعادة العَظَمَة لأمريكا" الذي ما انفك يتغنى به ليلا نهارا، إلى أن يُحْيِيَ تلك العَظَمَة التي خالجت الولايات المتحدة في تلك اللحظة المفصلية الفارقة في تاريخ عالمنا المعاصر، لحظةِ سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي برمّته، غير أنّه يدرك، في قرارة نفسه، أن ذلك لن يكون ممكنا في ظل التحولات التي طرأت على الولايات المتحدة من ناحية، وعلى تركيبة العالم وموازين القوة فيه من ناحية أخرى...
واعتبارا لذلك فإنّ الولايات المتحدة، وفقا لما جاء في الاستراتيجية، تتّجه نحو تقليصِ الخريطة العالمية التي ستعيد الانتشار فيها، وتخفيضِ الأعباء التي ستتحمّلها من أجل ذلك بنقلها كليا أو في جانب كبير منها إلى الحلفاء والشركاء، غير أنّ تطلعاتها تظل، على العكس من ذلك، مترامية الأطراف، وهو ما يجعلها، في نظر العديد من المحلّلين، صعبة المنال، لاسيما وأن التغييرات التي الرئيس دونالد ترامب على أساليب التحرك ووسائله أثارت الكثير من الاستياء والانزعاج لدى الحلفاء والشركاء، ودفعت الخصوم والمنافسين إلى توخي المزيد من الحذر واليقظة وإلى التحفز تأهّبا للتعاطي مع المستجدات القادمة، لا محالة...
وقد أكّدت الاستراتيجية على رغبة الولايات المتحدة في التعاون وتقاسم الأعباء والعمل المشترك مع الدول الحليفة والشريكة في مختلف الأقاليم التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى أمنها القومي، غير أن هذه الرغبة لا يمكن أن تتحقق في ظل سياسة تقوم على الإملاء والتخويف، وقوّة ناعمة تمارس دبلوماسية قسرية لا همَّ لها إلاّ تحقيق المصالح الأمريكية تجسيما لشعار "أمريكا أوّلا"...
وما يُخشى في هذا الإطار هو أن تؤديَ مغالاةُ الولايات المتحدة في تغليب المصالح التي تسعى إلى تحقيقها، وفي نفس الوقت، في تجاهل مصالح الدول الأخرى، إلى تصادمٍ حادٍّ للإرادات مما من شأنه أن يعقّد أوضاع العالم ومشاكله بدلا من حلّها... وليس ذلك بالأمر المُسْتَبْعَد في ظل عقدة التفوق الأمريكي المتضخِّمَة التي ما تزال تتحكم في سلوك الولايات المتحدة وخاصة رئيسها غريب الأطوار دونالد ترامب.
وانطلاقا من أنّ الوقائع تثبت أن التفوق الأمريكي ترسّخ بالاستناد إلى القوة العسكرية، ولم تكن له أبدا علاقة بالقِيَم والأخلاق (إلاّ على مستوى الخطاب)، فإنّ المنطق يقتضي تَوَقُّعَ أن تلجأ الولايات المتحدة إلى استخدام قوّتها العسكرية مستقبلا، لا فحسب لمواجهة أي خطر داهم قد يحدق بها، بل أيضا من باب الوقاية والاستباق... وهذا ما تؤكده قراءة ما بين سطور "استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة"، واستراتيجية وزارة الحرب لسنة 2026 التي جاءت بعد أسابيع معدودة، لِتثَنِّيَ عليها، ولتفصّل الحديث عن بعض إلمَاعَاتِهَا المُخْتَزَلَة./.
محمد إبراهيم الحصايري
قراءة المزيد
• من رسائل "استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة" - الرسالة الأولى: رسالة إلى العالم
• رابعةُ رسائلِ "استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة": الرسالة إلى منطقة "نصف الكرة الغربي"
• خامسةُ رسائلِ "استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة": الرسالة إلى آسيا ومنطقة الهندي الهادئ
• سادسةُ رسائلِ "استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة": الرسالة إلى أوروبا
• سابعةُ رسائلِ "استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة" الرسالة إلى الشرق الأوسط
• ثامنةُ رسائلِ "استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة": الرسالة إلى إفريقيا
- اكتب تعليق
- تعليق