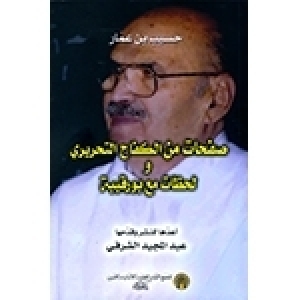الوجه الآخر من التّاريخ المنسي - صورة عن السِّيَاسِي عبد الحميد بن مصطفى: حلقة مهداة إلى المؤرّخ حبيب القزدغلى

(1).jpg) بقلم عزالدين المدني - كان من أقرب النّاس إليّ بعد سنوات من الصّداقة والعشرة. كان يفوتني كِبَرًا بحوالي عشرين سنة. عندما عرفته بدا لي لأول وهلة من الجيل الّذي سبقني، جيل شقيقي محمّد بِكر والدي، جيل المتَعلّمين والمثَقّفين من خّريجي الصّادقية والخلدونية ومعاهد فرنسا الّذّين كُنّا نعتبرهم شخصّيات مهمّة وخلال السنّوات الأخيرة في عهد الاستعمار على رؤوس البعض منهم الشّواشي الحمراء المجيّدي المائلة على جبينهم وبأيدهم محافظ الوثائق والجرائد التونسية والفرنسيّة، يتحلّقون كلّ صباح حول طاولة خاصّة بهم في مقهى، عليها فناجين القهوة وأواني الحليب والسّكر وطبق البِريُوش، وهي أوانٍ فاخرة لا يستعملها نادل المقهى العجوز بشكل بروتوكولي إلّا ليخدم بها هؤلاء الرّواد في الصّباح. ولَمَّا كبرتُ كنت أبكّر صباحًا في هذا المقهى، الكلاريدج الواقعة بآخر شارع الحبيب بورقيبة لأدرس مدّة ساعة مع من أعرفه من عشاق الفلسفة صفحات من كتاب "ما التّفكير؟" للفيلسوف الألماني مَرْتَانْ هَيْدقر الّذي عرفنا سيرته فيما بعد أنّه كان نازيًّا من عظماء النّازيّين الجامعيّين بجامعة فَرايْبُورْقْ إن بريزقو في جنوب ألمانيا...
بقلم عزالدين المدني - كان من أقرب النّاس إليّ بعد سنوات من الصّداقة والعشرة. كان يفوتني كِبَرًا بحوالي عشرين سنة. عندما عرفته بدا لي لأول وهلة من الجيل الّذي سبقني، جيل شقيقي محمّد بِكر والدي، جيل المتَعلّمين والمثَقّفين من خّريجي الصّادقية والخلدونية ومعاهد فرنسا الّذّين كُنّا نعتبرهم شخصّيات مهمّة وخلال السنّوات الأخيرة في عهد الاستعمار على رؤوس البعض منهم الشّواشي الحمراء المجيّدي المائلة على جبينهم وبأيدهم محافظ الوثائق والجرائد التونسية والفرنسيّة، يتحلّقون كلّ صباح حول طاولة خاصّة بهم في مقهى، عليها فناجين القهوة وأواني الحليب والسّكر وطبق البِريُوش، وهي أوانٍ فاخرة لا يستعملها نادل المقهى العجوز بشكل بروتوكولي إلّا ليخدم بها هؤلاء الرّواد في الصّباح. ولَمَّا كبرتُ كنت أبكّر صباحًا في هذا المقهى، الكلاريدج الواقعة بآخر شارع الحبيب بورقيبة لأدرس مدّة ساعة مع من أعرفه من عشاق الفلسفة صفحات من كتاب "ما التّفكير؟" للفيلسوف الألماني مَرْتَانْ هَيْدقر الّذي عرفنا سيرته فيما بعد أنّه كان نازيًّا من عظماء النّازيّين الجامعيّين بجامعة فَرايْبُورْقْ إن بريزقو في جنوب ألمانيا...
وفي عشيّة النّهار أعود إلى مقهى باريس وكأنّه كان مرفئي الإعتيادي لأستريح وأخفّف عن نفسي عناء العمل اليومي، وما أثقل العناء في مجال الصّحافة وما أصعبه! لكن كلّما دخلت المقهى في تلك السّاعة ألاحظ وجوده الّذي كان يسترعي دائمًا انتباهي لاسيّما أنّ بعض الفنّانين والكُتاب الشّبّان يجالسونه ويخوضون معه في جوّ كلّه راحة وابتسام ونقاش وأخذ وردّ...
فمن يكون هذا الشّخص الجالس بين الشّبّان؟ ذلك أنّه من القليل أن يخالط الكهول والشّيوخ الشّبّان خاصّة من الفنّانين!...
الحقّ إنّي لا أتذكّر اليوم مَنْ مِنَ الكُتّاب قدّمني إليه بوصفي مسؤولًا عن الثّقافة في جريدة العمل لسان الحزب الحاكم. قال: أتشّرف فتصافحنا. أمّا هو هذا الرّجل الّذي بين عُمْرَين فهو الأستاذ عبد الحميد ابن مصطفى الّذي قد سمعتُ عنه في مقر الجريدة بأنّه أحد المسؤولين عن الحزب الشّيوعي... فجَلستُ بجانبه وتبادلنا بعض الكلمات وكأنّه يرحّب بي إذ أنّي كنتُ صحفيا وخالطتُ من أريد من أخالط وأصادق ولاحظتُ على الفور أنّه بَلْدِيّ وأنّ له سمات البلديّة التّونسيين في العاصمة، والأصحّ من المدينة العربية العريقة أو من بَارْدُو أو من المرسى. ولكن تيقَّنتُ أنّه ليس من أولئك القدامى المتقاعدين الّذين يأتون إلى مقهى باريس صباحًا لشرب القهوة ولربّما ليظهروا أمام عامة الرّواد الآخرين بأنّهم مازالوا على قيد الحياة بصحتّهم الموفورة رغم اعتمادهم على عكاكيزهم ومقبضها كلّها فضّة!... تصوّرتهم إداريّين ومسؤولين حكوميّين قدامى كانوا قيّادًا وكواهي وخلفاوات في العهد البائد!
نعم، أكيدًا له سِمَات البَلْدِّية: جلوس مريح بلا تكلّف، نحافة جسمه وأطرافه، قصر قامته، بياض بشرة وجهه في شكل لوزة، مقبّب دماغه عليه شعر خفيف ممشوط على جانب، أنفه بارز شيئًا ما، شفته رقيقة، صوته منخفض حين يكلّمك، في عينيه لألأة الذّكاء والفطنة، في ناظره تحديق فيك إذا ركّز اهتمامه وأصغى إليك، فيجيبك بعد لحظة صمت، ولا يفرض عليك نفسه ولا حضوره ولا كلامه، ولا يقطع أقوالك لكي يعارضك ولا يحتكر وقت الجلسة معه بشلّال من الأفكار الصّحيحة الرّائجة والدّعائية الباطلة إذ ليستَ في حلبة صراع معه حيث صراع الغالب والمغلوب إلى أن تضمّ لسانّك في فمك وتسكت! وكان بعيدًا كلّ البعد عن إعطاء دروس الأخلاق والسّياسة... والحاصل أنّه كان متواضعا، تواضع الكبراء لا الحفتريش!
كثيرًا ما جلستُ بجانبه أو قبالته في المقهى، لا في مقهى باريس فقط بل في مقهى أفريكا أيضًا وكذلك في مطعم بغداد حيث نتقابل مع رسّامين وسينمائيّين ومسرحيّين مشهورين في تلك الأيّام البعيدة عنّا الآن، نعرفهم بأنّهم مُقَوِّشُون يتملّحون من النّظام أي أنّهم من أقصى اليسار حسب الاصطلاح السّياسي الفرنسي. وقد أصدرتُ في أواخر الستينات بيان الأدب التّجريبي في محاضرة ألقيتُها في دار الثقافة ابن خلدون أمام جمع كبير من هذا الجمهور اليساري بحكم فنونهم وآدابهم، فيهم رؤوس متوسّطة الحجم من النّظام الحاكم، وماركسيون وكتّاب وشعراء وموسيقيون ورسّامون ومسرحيّون شبان، كما أصدرتُ في نفس تلك السّنوات المتَّقِدة الفصل الأول من قصّتي التّجريبية "الإنسان الصّفر" ونشرته في مجلّة الفكر لمحمّد مزالي وبموافقته وقد وجد هذا الفصل الأول ضجّة استنكار واحتجاجا عليّ شخصيًا من قبل القّراء بل انقلب إلى تهديد ووعيد من طرف أغلب رجال الدّين ومحترفي السّياسة السّلطويّة وجهّال النّظام الحاكم.. فكان ردّي عليهم الصّمت المتعالي مع نشر الفصل الثّاني فورًا ثمّ الفصل الثّالث فورًا على صفحات نفس المجلّة... رغم أنفهم جميعًا!
لا شكّ أنّ الصّديق العزيز عبد الحميد ابن مصطفى كان على علم بكّل ما ذكرتُه الآن (في خطوطه العريضة) لأنّه قارئ ممتاز يفلي الصحّف والمجلّات التّونسيّة الصّادرة باللّغة العربيّة وباللّغة الفرنسيّة حاليًا فضلا عن بعض الجرائد الفرنسيّة. وعندما تبادله الرّأي أو تناقشه في نطاق الميدان السّياسي والاقتصادي والاجتماعي تتفطّن لَحْظَتها أنّه مطّلع على آخر الأخبار مع الإلمام بالقضايا، ولكنّك تراه في نهاية المناقشة مفكّرًا في الشؤون السّياسيّة الوطنيّة وحتّى الخارجيّة أيضًا. ولم يقتصر تفكيره الطرّيف على السّياسة والسّياسيّين وإنّما تجاوز إلى الثّقافة... فقد كان عليمًا بأي حدث ثقافي وطني... يجدّ في البلاد. وخلاصة القول إنّه كان مفكّرًا سياسيا رحمه الله. والحقّ أنّ الثّقافة لم تكن في تفكير عبد الحميد ابن مصطفى شأنًا غريبًا عنه، فلم يعتبرها طوال سنوات صداقتنا أمرًا كماليًّا أو تكميليًّا أو تشريفاتيًا مثل النّيشان على الصّدور! أو تكميليًا أي أنّها ليست شيئًا ضروريًّا ولا مُلزمً في المجتمع بل هي مجرّد الكماليات كالحلوى بعد الشّبع!.. لذلك لم يصفها الأستاذ عبد الحميد أبدًا بالتّلهيّة للجماهير ولا بالتّهريج التّافه، وهو موقف مشرّف لكنّه هو على عكس ما ذهبَتْ إليه معظمُ الأنظمة السّياسية التونسية السّابقة خلال جلّ أوقات سلطتها وحكمها فاعتبرت الثقافة أمورًا ثانوية لا أهميّة لها مطلقًا! لأنّها حسب رأيهم مضيعة للوقت وللمال وللإنسان!!! بواسطة هذا الاستخفاف إن لم أقل: هذا الازدراء السّياسي انغلق أحد أبواب التّعبير والحرّية على المبدعين الكُتّاب والشّعراء والفنّانين من شتّى الاختصاصات فوجدوا أنفسهم في الأغلب الأعمّ من الأوضاع الاجتماعية في درجة ثانيّة بل خامسة وعاشرة وتحت الصفر أحيانًا! ولا أحد من تلك الأنظمة السّياسيّة السّابقة الّتي باتت متدهورة اهتّم بهم اهتّماما معنويًا وماديًّا واجتماعيًّا ودوليًّا إلّا بصفة شكلانيّة وتشريفاتية منافقة وخَدَمَاتِّية ليتخلّص منها ومنهم ومن الثّقافة على جناح الطّائر! لأنّهم لا يعرفون الثّقافة الحيّة الحديثة والحداثيّة ولا يعترفون بأيّ مبدع خلّاق تونسي قد أضاف إضافة جبّارة بأعماله الفنّية إلى السّابق من الثّقافة والفكر الحرّ، ولا يقرأون كتابًا لأنّهم يكتفون بما درسوه في دور التّعليم وتلك هي ثقافتهم التعليمية الهزيلة ولا يزورون أروقة الرّسم والمعارض الّتي تقلقهم وتزعجهم وتخنقهم ولا يذوقون منها شيئًا، ويبتسمون ابتسامات دبلوماسية أخذًا بالخاطر. ومراجعهم هو الخارج لا الوطني والمفتوح على شاشة التّلفزات الأجنبيّة الأمريكيّة والفرنسيّة والإيطاليّة والأنڤليّزية، فيستيقظون صباحًا مخمورين بأمريكا وفرنسا وأوروبا لا غير. ويقول المثل التّونسي وهم المالكون على الدّوام: الكراسي والمناصب والأفاريات: "معيز ولو طارُو!!" وفي الأخير، المهّم هو ما في جيوبهم لا الوطن ولا الشّعبُ ولا تونس ولا سيدنا زكري! وممّا زاد في غطرستهم ورفضهم للآخر وجهلهم وظلمهم الّلطيف أنّهم لم ينتبهوا إلى غضب الكُتاب والفنّانين الّذين قرعوا نواقيز التّمرّد والثّورة والمواجهة قبل المعارضة السّياسية المنظمّة. والثقافة هي دائمًا سبّاقة تسبق الأحداث... أمّا هؤلاء السّاسة المتخّلفون... وقد مات الرّسام العبقري المجدّد نجيب بلخوجه والغصّة في قلبه! ومات الشّاعر عبد الحميد خريف والغّصة في قلبه أيضًا!.. ومات أوّل دكتور دولة تونسي محمّد فريد غازي المثقّف والكاتب والباحث الحرّ وغصص في قلبه!... وَاحَرَّ قَلْبَاهُ!... واعتقادي الرّاسخ أنّ عبد الحميد ابن مصطفى أحبّ المبدعين الفنّانين والكتاب والشّعراء والنّقّاد فكان يحترمهم واحدًا واحدًا ويسأل عنهم إذا غابوا وعن مشاريعهم وأعمالهم إذا حضروا وتحلّقوا حوله أو بجانبه في المقهى ويشاركهم في أجوائهم مثل أخي الرسّام نجيب بلخوجة الذي دعاه إلى حضور سهرة في بيته بنهج المناطقي (الباب الجديد) فاستجاب، ودعوتُه أنا إلى مشاهدة مسرحيّة بالمركز الثّقافي الدّولي بالحمامات فلبّى دعوتي فنقلته معي في سيّارتي القديمة (د.إس) إلى مسرح الهواء الطلق هناك... وكم مرّة شاهد عبد الحميد بن مصطفى الأفلام في قاعة سينما المونديال نهج ابن خلدون. كان معنا دومًا وواحدًا منّا ولم يخالطنا نحن شبان الابداع والفّن من أجل انخراطنا في حزبه. لأنّه كان مؤمنا بالحرية، لأنّه كان حرًّا حديدًا.
نعم! كان لا ينوي بفضل سلوكه معنا أن يوظفّنا لغايات حزبيّة وسياسيّة وشخصيّة. فهو بريء من هذه النّوايا السّخيفة. وكان عبد الحميد ابن مصطفى رحمه الله بألف رحمة هادئ الطبّع والسّلوك فأحببتُ فيه الهدوء وكذلك هيئته المحترمة التّلقائية في نقاشه الرّصين معك ومع الآخرين من أندادك المثقّفين والفنّانين: الكلمة بالكلمة، والرأي بالرّأي، والمعلومة بالمعلومة، والتّحليل بالتّحليل، والحجّة بالحجّة. ونَظلّ نتسقرط وكأنّنا من المَشَّائِين أو من أهل الرّواق...
غايتنا الّتي أعلناها جهارًا في تونس والخارج أن لا وصاية على المثقّيفن والفّنانين ولا على تونس وثقافتها. ولا احتكار للوطنيّة من قِبل أحد في بلدنا وعصرنا ومستقبلنا. ولا احتكار للمسؤوليّة ولا للأفضليّة ولا للجهويّة ولا للمحلّية ولا للأقدميّة. هذا ما أعلنا عنه يومها والشيخ العفريت يغني وصوته يلعلع! في دهليز دار الثّقافة ابن رشيق الّذي جعلناه دارًا للفكر الحرّ، دارًا للطلّيعة الفكريّة والفنيّة والأدبيّة الّتي ما لبث أن إلتَفَتَ إليها نظام الحزب الواحد، فبدّد بعد ثلاث سنوات شأنّها شيئًا فشيئًا حتّى انحلّت وتفرّق روّادها. وعلى كلّ، كان النّشاط الفكري الطلّيعي في الدّهليز ليس من وحي صديقنا العزيز عبد الحميد ابن مصطفى بل من وحي الجو السّياسي والاقتصادي الخانق. فهاجرت إلى الخارج!
رحمه الله ذاك الرّاجل الفقيد! وألف زهرة حمراء خالدة على قبره!
عزالدين المدني
قراءة المزيد
الجانب الخافي من تاريخ تونس الحديث والمعاصر: نحو رفع الحجاب
الجانب الخافي من تاريخ تونس الحديث والمعاصر: لمحات عن فكر عبد الحميد بن مصطفى
- اكتب تعليق
- تعليق