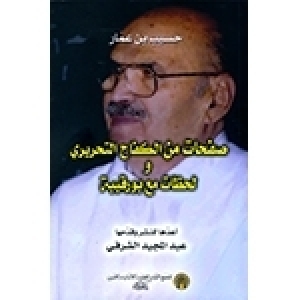مختار اللواتي: عينٌ على الحاكم، وعينٌ على المحكوم
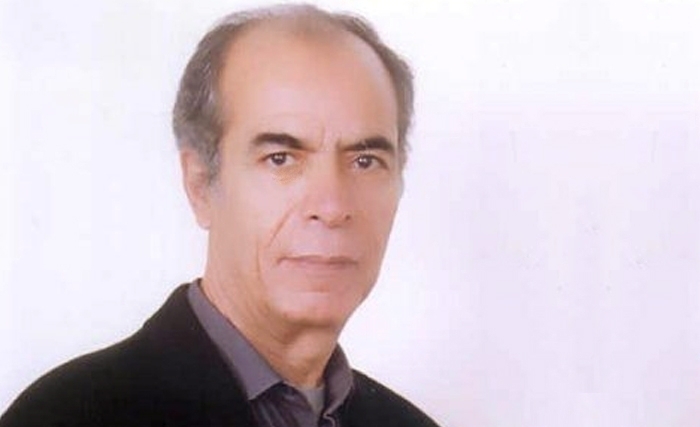
أنا من صنف المواطنين المنضبطين للقانون، وإن كنت دائم المشاكسة من أجل ضمان عدله وإنفاذه على الجميع..
لذلك، وبناءً عليه، كما يشاع ويُنسب للمشتغلين والمشتغلات، بالقضاء والمحاماة، فقد التزمت بقرار الحجر الصحي العام، من أول يوم تم إصداره فيه. وما أغادر البيت، كل أسبوعين تقريبا، إلا، فعلاً، لأمرٍ ضروري، مثل شراء بعض محتاجات المؤونة، ولزوميات ما يلزم من مواد التنظيف والوقاية المتنوعة، وآخرتها الواقي (العُلوي والله).
الخرجة الأخيرة كانت بالأمس، أي بعد سابقتها بأربعة عشر يوما بالتمام والكمال، وبعد يومٍ من بداية تطبيق العودة التدريجية ذاتِ الشروط التي بينها نيابة عن رئيس الحكومة، أربعةٌ من وزرائها في ندوتهم الصحفية التي قاربت الساعتين. مع دعواتي بأن يكون مانع تغيب إلياس الفخفاخ، عن القيام بهذه المهمة، خيراً. خاصة وإنه لم يظهر كذلك في حوار تلفزيوني جديد، خلافا لما كان وعد به بأن يجعل ذلك الحوار المتلفز دوريا!!
على كل، في خرجاتي السابقة كنت أقصد إحدى المغازات الكبرى في محيط سكناي، أو غير بعيد عنه كثيرا. لكنني جمعت نُتَف شجاعتي هذه المرة وقصدت مركز مدينتي، صفاقس، أو ما يُعرف بباب بحر.
كنت طوال الطريق، وأنا أقود سيارتي العتيقة التي جنيت عليها وعلى نفسي بما وشَّحتُها به من صور ومقولات لشخصيات مناضلة في ميادينها من القرن الماضي، فأضحت قبلةَ الأنظار، من الكبار ومن الصغار، ومحلَّ استفسار من بعض أعوان الأمن الأبرار. قلت، كنت طول الطريق، دائمَ التركيز علَّ شرطيٍّ يعنُّ له ان يوقفني، ليس للسؤال عن سر هذه التواشيح، وإنما عن ترخيص خروجي مستهترا هكذا. فبم عساي أجيب؟؟ أأقول ببساطة، أنوي التبضع؟؟ أو إنني اشتقت للمدينة فقلت أزورها حتى وإن كانت خالية من روادها ومن أبنائها وبناتها؟
لكن والحمد لله، لم ألحظ أي حظور أمني، لا في ذهابي ولا في إيابي. غير إن ما ادهشني هي تلك الحركية الكثيفة على الطريق. أرتالٌ من السيارات الرائحة والغادية من وإلى كل الإتجاهات، وتلك الأسراب من الخلائق على جانبي الطريق، وهي تتبادل اطراف الحديث في سيرها الهوينا، مثنى وثلاثا.. وكلما مررتُ من أمام محل تجارة أو أي حرفة من توع إصلاح السيارات أو الدراجات النارية والهوائية، وتنظيف الملابس وكيها وغيرها، إلا ووجدتها فاتحةً أبواب رزقها. وصلت "باب بْحَرْ" بأمان، ركنت السيارة لصق الكرنيش وقصدت البنك، أول مقاصدي. وفي الطريق إليه، لاحظت محل بيع "الزلابية والمخارق والفطاير العسلية واليويو وبقية الحلويات مؤثثة سهراتنا الرمضانية، مفتوحا وقد اصطف على جانبيه خلق كثير لشراء ما لذَّ وطاب. وأطلت عنقي لأضبط المشهد الداخلي للمحل، فوجدت الشاف منهمكا في العجن ومساعديه يتقاسمون الأدوار بين القَلْيِ واللَّفِّ وقبضِ النقود. فقلت في نفسي لابد أن المطاعم والمقاهي هي الأخرى قد فتحت أبوابها. ولكن بمروري من أمام أحدها ثم إحداها عرفت أنها لم تعد إلى العمل بعد. وصلت البنك فكان في غاية التنظيم واحترام قواعد التباعد. وكان موظفوه وموظفاته ملتزمين بألبسة الوقاية. وبعد أن قضيت ما أتيت لأجله وقفلت خارجا، وقفت، قبل الوصول إلى الباب، على باب مكتب رئيس الفرع، فتبادلنا التحية والسؤال عن الأحوال. وقبل أن أودعه وأخرج، شكا لي من تهور بعض الحرفاء كبار السن الذين أكثروا من التردد على البنك، دون اعتبارٍ لخطرِ عدمِ الإلتزام بالحظر الصحي العام. وقبل أن أبرر له قدومي إلى البنك اليوم، أكد لي أنه لا يقصدني، وهو يعرف أنني منذ شهر لم أدخل البنك، وإنما من أشخاص اتخذوا البنك بديلا عن المقهى، فقط لتبادل الحديث مع الموظفين وتقصير الوقت، غير مبالين بما قد يعرض صحتهم وصحة غيرهم للخطر.
تركت البنك وقصدت السوق المركزي، لؤلؤة الأسواق في المدينة، لأدلل النفس ببعض المشتريات التي أحتفل بها في أول أيام مصافحتي لجرايتي قبل توديعها. وقبل أن أدلف إلى داخل السوق، سمعت صوتا يناديني مبتهجا. إلتفتُّ فوجدته أحد الأصدقاء قال إنه خرج هو الآخر لقضاء بعض الشؤون. ولكن ترحيبه المبتهج بي، لم ينجح في إخفاء حالة كدر وغمٍّ باديين على هيئته وملامح وجهه وهي بلا واقٍ. فسألته عن الصحة. طمأنني أنها بخير، ولكن ما أفقده صوابه، قال "هؤلاء الذين يحكمون البلد، ويأخذونه إلى الهاوية" ! وقبل أن أحاول التخفيف عليه، مضى في حديثه وهو يُربد ويُزبد، كما يقال، " لقد حدثني إبني من الكويت البارحة، بأنه ومئات من زملائه وزميلاته، وغالبيتهم مدرسون، عجزوا في إيجاد سبيل للعودة إلى أرض الوطن. تخيَّل، إنهم عبَّروا عن استعدادهم لدفع مقابل إيوائهم في أماكن الحجر الإجباري عند عودتهم، ودفع تكلفة العودة مهما غلت، ولكن لا أحد اكترث لحالهم. بل إن فيهم من توفيت والدته وحُرم من وداعها الوداع الأخير. بل هناك من وضعت زوجته وليدها الجديد ولم يتمكن من مواكبة هذا الحدث السعيد في حياته. وأضاف صديقي أنه علم أيضا أن تونسيين آخرين مقيمين في السعودية قد صُدِموا بنفس الإهمال من دولتهم. أ إلى هذا الدرك الأسفل وصلنا؟؟ أهذه دولة؟؟ أهؤلاء حكام؟؟"
هدَّأتُ من روع المسكين، وقلت له "أعذرك على ما أصابك من انفعال بسبب ما رأيتَه إهمالا من السلط في بلادنا. ولكن هم معذورون يا صديقي. فالفتق اتسع على الراتق. وإمكانيات إرجاع كل الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من كل أرجاء العالم، وهم يُعَدون بمئات الآلاف، لا تسمح بذلك في مثل هذا الظرف العصيب وفي ظل هذا الحجر الصحي العام. لذلك، تم إعطاء الآولوية للعالقين بالفعل، من الذين كانوا في مهمات بالخارج، مثل ملتقيات وتربصات، أو طلبة وعاطلين عن العمل فقدوا مورد عيشهم". وبدل أن تخفف عنه كلماتي كَدَره وغمَّه، قد زادتهما التهابا. فحَدَجَني بنظرة يائسة كمن خاب ظنه فيمن اصطفاه مُغيثاً. وقال بعد تنهيدة حرَّاء، " لقد كان أولئك المساكين العالقون في الكويت على يقين أن صراخهم قد ذهب أدراج الرياح، فالتجأوا إلى وزير خارجية ذلك البلد علَّه ينجدهم ويجد لهم مخرجاً." ثم ذهب دون سلام أو انتظار عتابي على من قاموا بذلك التصرف غير السليم. لقد تركني صديقي شاردَ الذهن وانصرف غاضبا، لست اأدري أمِنِّي أنا، أم من الحكومة. أم من الإثنين معاً ! لكن الأمر الواضح هو إنني فشلت في إقناعه بما قدمت له من حجج رأيتها منطقية. وحتى عندما قمت بمراجعتها واحدةً، واحدة، وجدتها صحيحة برغم كل ما أحمله من نقد للحكومة ومن معارضة لمنظومة الحكم برمتها. لكنني، اكتشفت من حديث صديقي تقصيرا كبيرا في التواصل مع جاليتنا سواء كانت في الكويت أو في السعودية أو في غيرهما من بلدان العالم لشرح المعطيات على أرض الواقع، ولدرس وضعيات طالبي العودة، لمعرفة إن كان بينهم مَن هم فعلا تستدعي ظروفُهم العائلية عودتهم، أو من هم في ضائقة مالية. ولطمأنتهم وإشعارهم أن دولتهم تقف إلى جانبهم، وماهي إلا فترة من التضحية الجماعية وستزول بأخف الأضرار. كل هذا مع وجوب إدامة التواصل مع الشعب في الداخل لإطلاعه على تحركات الديبلوماسية التونسية خارج أرض الوطن، إن هي فعلا قامت بما كنت أشرت إليه في الأسطر السابقة، وهو محل شك.
تقدمت إلى داخل السوق مهموما. وجدته حافلا بالحركة دون اكتظاظ ووافرَ السلع المغرية والأسعار الكاوية. وقفت عند باب الجزار، وطلبت قليلا مما يصلح شواءً. رحب وشرع في قصِّ ماطلبت، فيما ثبَّتُّ عينيَّ عليه كي لا يباغتني ويزيد في الوزن أو يدس لي بعض الشحوم. والحقيقة أنه لم يفعل. وفي اللحظة التي كاد أن يضع فيها المطلوب في كيس، ناداه صديق له فأرجأ ما كان سينهيه واستلم منه بعض النقود هو باقي حساب بينهما، كما فهمت، ثم عاد ليمسك بقطعات اللحم ليضعها في الكيس. ولما نبهته لخطورة ما فعل على الصحة، وأردت أن أشرح له أن قطع النقود المعدنية بالذات هي أكبر ناقل للعدوى، تبسم في شبه استهزاء، وهو يقول بصوت الواثق المطمئن، "لاباس لاباس، ياحاج".
نسيت ان أقول لكم، إنني بُعَيْدَ خروجي من البيت وقبل أن أمتطي سيارتي العجوز الجميلة تلك، تذكرت بأنني لم أضع الواقي على أنفي وفمي. فرجعت أدراجي وحملته. غير إني لم أر كثيرين، سواء في الشارع أوفي محلات عملهم، واضعين الواقي، أو تكسو أكفهم قفازاتٌ عند لمس النقود.
قبل أن أدخل السيارة وآخذ طريق العودة ، فتحت كبسولة حرصت على اصطحابها معي في خرجتي، وكانت من مشترياتي في خرجةٍ سابقة، وعقمت منها كفَّيَّ.
ولعل النتيجة التي عدت بها من خرجتي الصباحية تلك ، هي إن غياب الوضوح والمتابعة في برامج الحجر الصحي ورفعه التدريجي، من قبل السط المختلفة، قد ولَّد شيئا من الإستهتار والإستخفاف بالخطر، كانا جلييْن في سلوكات الكثيرين. وآخرهم رجل قطع عليَّ الطريق على حين غرة وهو راكب "موبيلاته" الشخماء، وفي قفاه زوجته وبينهما حُشِر إبنهما. والحمد لله كانت سليمة.. ولاباس!
- اكتب تعليق
- تعليق