الشاذلي القليبي: »...تعـــالَوْا إلى كلمة سَواء...«
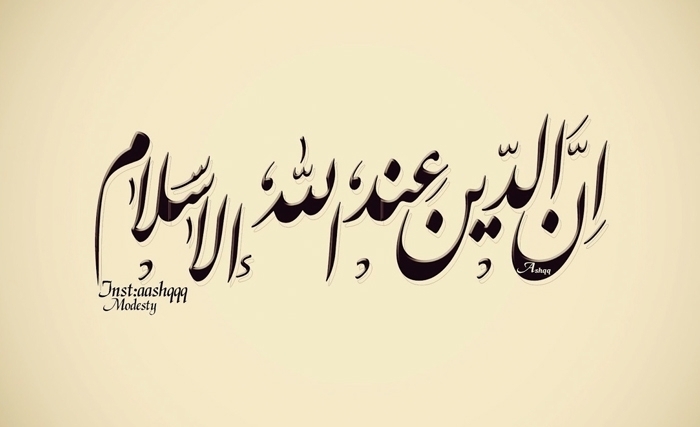
أغلب النصوص المقدّسة، في الدّيانتين اليهوديّة والمسيحيّة، لا يعتبرونها «مُنزَّلةً» في نصوصها وألفاظها ؛ وأكثرها منسوب إلى أنبياء أو إلى رجال اشتهروا بالتقوى والصلاح.
أمّا القرآن، فالمسلمون يؤمنون بأنّه نُزّل على الرسول محمد – عليه صلاة الله وسلامه – بسُوره وآياته وكلماته : فلا يخطر ببال أيّ مسلم أنّ آيات منه، يتطرّق إليها الباطل، بصورة من الصور.
أمــا ما يُروَّج له، في بعض البلاد الأوروبّية – رُبّما بإيعازات مُغرضة – من أنّ القرآن يبثّ الحقد، ويَحُثّ على أعمال العنف ضدّ أهل الكِتاب، فهذا القول ناتج عن سوء فهْم للنصّ القرآني، إمّا مِن قِبل فئات تدّعي الدفاع عن الإسلام، وإمّا مِن قِبل خصوم للإسلام، اطّلعوا على القرآن بواسطة ترجمات قد تكون غير محكمة؛ ولعلّهُم يجهلون أوضاعا تتعلّق بالفترة الجاهليّة، وما كان فيها من مواجهات، بين دعاة الإسلام والفئات المناوئة لهم.
لكن التوصية الصادرة إلى المسلمين، وهُم مضطَهدون بمكّة، أن يتمسّكوا بالصبر، وأن لا يردّوا الفعل – أغلب الظنّ عندي أنّه يُقصد منه، خاصّة، وقاية للمجتمع المكّي من انتشار الفتنة. فلمّا انتقل مقرّ الدعوة إلى يثرب – التي سُمّيت منذئذ بـ«المدينة» – رأى المشركون النّاس «يدخلون في دِين الله أفواجا»، فتألّبوا على المسلمين؛ وانضمّ إليهم مَن تحالف معهم، مِن اليهود – رغم أنّ المسلمين أقرب إلى اليهود من المشركين، من حيث العقيدة ؛ ولكن غلبت عليهم أوضاع الجاهليّة الجهلاء، فغلَّبوا سياسة المصالح. فإذّاك صدر للمسلمين الإذن بالقتال، لكن خارج «أسوار» المدينة؛ واتّخذت المجابهة نمط الحرب بين معسكرين. وهذه الآيات التي تحرّض على القتال، إنّما هي حينئذ ظرفيّة، للتحريض على الدفاع، ولردّ العدوان، في ظروف مُعيّنة، وهي إذن لا تأمُر بواجبات ثابتة، غير مقيّدة بزمان ولا بمكان.
ومعروف أنّ عددا من أبرز الشخصيات اليهوديّة اعتنقوا الإسلام، وتبوّؤوا منازل عالية في المجتمع الإسلامي.
 ومعروف أيضا أنّ في القرآن آيات كثيرة تشيد بموسى وهارون – حتّى قيل، تفكّها، إنّ القرآن ، في جُملته، «قال موسى». والقرآن يشيد بالأنبياء الذين ينتسب إليهم موسى، إذ يقول: «واذكر عبادَنا إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ... إنّهم عندنا لَمِن المصطفَين الأخيار...».
ومعروف أيضا أنّ في القرآن آيات كثيرة تشيد بموسى وهارون – حتّى قيل، تفكّها، إنّ القرآن ، في جُملته، «قال موسى». والقرآن يشيد بالأنبياء الذين ينتسب إليهم موسى، إذ يقول: «واذكر عبادَنا إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ... إنّهم عندنا لَمِن المصطفَين الأخيار...».
وما جاء في القرآن عن المسيح وأمّه، يكتسي روعة عالية؛ وما جاء سلبا في حقّ فئات من اليهود، فللتذكير بذنوب كانوا ارتكبوها في حقّ دينهم.
وموقف القرآن مِن اليهود – ويُسمّيهم «بني إسرائيل» – يَتلخّص في قوله: «ولقد آتينا بني إسرائيل الكِتابَ والحُكمَ والنُبوّةَ ورزقناهم مِن الطيّبات وفضّلناهم على العالَمِين».
ثمّ إنّ القرآن، في حديثه عن الديانتين السابقتين، لا يقتبس ممّا جاء قبله من كُتب. فالمسلمون يُؤمنون بأنّ القرآن صادر عن الخالق، عزّ وجلّ، الذي هو مصدر الرسالات السماويّة، كافّة، ومُنزِّل سائر الكُتب، جميعا، ومنها القرآن : «وهذا كِتابٌ أنزلناه إليك مُباركٌ مصدِّقُ الذي بين يديه»؛ ويقول، عزّ وجلّ، مُخاطِبا رسوله: «والذي أوحَينا إليك من الكِتاب، هو الحقّ، مُصدِّقا لِما بين يدَيه...». أي مُصدِّقًا للتوراة والإنجيل.
فالدّعوة التي أطلقها البعض إلى إلغاء آيات معيّنة من القرآن، يَعتبرون أنّ فيها إساءة إلى اليهود، هذه الدعوة تنُمّ، حينئذ، عن اعتقاد بأنّ القرآن مصدره بشري: وإلاّ فإنّ الإيمان ينتقض جميعه، إذا المؤمنون ادّعوا، فيما نُزّل بالوحي، لفظًا ومعنى، التمييز بين ما هو صالح وما هو مؤذِ، في نظرهم – مُخالِفين بذلك إرادة الخالق، عزّ وجـــلّ. أمّا إذا دعوتهـــم تَعنــي أيضا تطهير الشروح والتفاسير، من عائلات بثّ الكراهيّة، فهذا دليل على أنّهم غير مُطّلعين على ما صدَر، منذ قرون متتالية، من شروح عالية الشأن، بعيدة المقاصد،نقيّة الأغراض.
أمّا إذا تعلّق الأمـــر بما يذهـــب إليه بعـــض المسلمين، في تعصّبهم الجائر، فالمشكل عندئذ ليس في النصّ القرآني، وإنّما هو ناتج عن سوء فهْم له، أو عن خلط بين الأوامر الظرفيّـــة، وبيـــن الواجبات الــــدائمة. والقضيّة هـــي إذن اجتماعيّة، وليســت دِينيّة. ومجتمعاتنا تعاني الويلات بسبب هذه الانحــرافـــات الضالّة.
أمّا إذا تعلّق الأمر بما ارتكبه اليهود، زمن رسولهم موسى، وفي عهد بعض أنبيائهم، من بعده فيعتبرون مجرّدَ التذكير به ثلبا في حقّهم، ويَدّعُون أنّه دعوة للكراهيّة – وهي، في عصرنا، التُهْمة «القاتلة»، في نظرهم، أو هُم يرجونها كذلك، لأيّ شعْب يكافح من أجل نيْل حقـــوقه – فإنّ ذلك إقحـــام لبعـــض الأغراض السياسيّة – ومنها هموم فلسطين وما إليها – في سياق الاعتبارات الدّينيّة.
هذه هي الأبعاد التاريخيّة لتشنّج العلاقة بين اليهود والمسلمين، لكنّها ازدادت تعفّنًا بقيام دولة لليهود، على أرض ملكيّتها في نزاع بين الطرفين.
والحقيقة، أنّ اليهود كانوا دوما على غير محبّة ولا وئام مع المسيحيّين، لأنّهم انتزعوا منهم شرف الرسالة ؛ وهُم، جميعا، أولئك وهؤلاء، في خصام مع الإسلام، لأنّه جاء مُصَحِّحــا لِبعض ما هُم عليه.
ولو أمعنوا النظر، لأدركوا أنّ الإسلام جاء مُشيدا بما نُزّل على موسى والمسيح، مُعتبِرا أنّ مجموع اليهود والنصارى – في أصل ما دُعُوا إليه – هُم جميعا، مع أتباع الدعوة المحمّديّة، يحقّ أن يُقال عنهم إنّهم «المسلمون»: «مِلّة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين مِن قبْلُ». ذلك أنّ «الدِّينَ عند الله الإسلام». «وما كان إبراهيم يهوديّا ولا نصرانيّا ولكن كان حنيفًا مسلما». «وإلهُنا وإلهُكم واحد ونحن له مسلمون».
وخُصوم الإسلام، لو أخلصوا النيّة، لتذكّروا أنّه يدعو أتباعه، إلحاحا وتكرارا، إلى تدبّر القرآن – وحُسن فهْم آياته، لفتْح الآفاق إلى ما يَكُون به الإسلام، حقّا، صالحا لِكلّ زمان ولِكلّ مكان، وشاملا لكلّ الفئات، مصداق قوله تعالى: «أفلا يَتدبَّرُون القرآنَ أمْ على قلوب أقفالها».
ولو فعَلوا لَتأكّدوا أنّ الإسلام دِين اجتهاد، يدعو إلى إعمال العقل في المقاصد، واعتبار المصالح العاجلة والآجلة، حتّى يبقى، دوما، سبيلا مفتوحا إلى دائم الارتقاء بالمجتمع، وإصلاح ذات البيْن فيه، وإلى دائم التسامي بالإنسان إلى ما ينبغي من درجات التطوّر والفلاح.
.jpg)
فالاجتهاد إذن، في الإسلام، ليس بمعنى إعادة صياغة الآيات – وهو مسّ بما جاء عن طريق الوحي – بل الاجتهاد إنّما هـــو الغـــوص في الأعمــاق من معاني الآيات، وإدراك لأبعاد من مقـــاصــد الإسلام.
فإذا سَلَّمنا بأنّ العلاقة بين أتباع الإسلام وبين أتباع الدّيانتين السابقتين، إنّما هي علاقة التقاء في الأصل، وهو الإسلام لله عزّ وجلّ، وأنّ هذه العلاقة اضطربت لدخول جيل من اليهود المُقيمين في بلاد العرب في حلف مع المشركين المُعادين للإسلام، فلا مَعْنى لاتّهام المسلمين باللاّساميّة – لا سيما أنّ العرب واليهود ينتمون، جميعا، إلى نفس الأصول العِرقيّة.
وقد كان ظهر التناغم بين الدّيانات السماويّة الثلاث، جليّا، في حضارة الأندلس، إذ شارك في صُنعها اليهود والنصارى، في مجتمع إسلامي بلغ قمّة من الحضارة، لا ميز فيه بينهم وبين المسلمين. بل إنّ الثقافة اليهوديّة شهدت، في الأندلس، تطوّرا عاليا لم يسبق لها مثله؛ وكان لأصحابها، في المجتمع الأندلسي، درجات مُتسامية من المسؤوليات.
وهــذا التمـــازج الحـــضاري الذي صَنع حضارة الأندلس، لم يَشهد مثلَه التاريخ من قبلُ، إذ كان ما قبْله من حضارات إنّما يَقوم على الميز والإقصاء، واعتبار المُغايرين، في الثقـــافة واللغة والدّيــن، من «البرابرة»: فيعيشـــون على هامش المجتمــع المتحضّر.
أمّا المسلمون، فيأمُرهم القرآن بأن «لا يُجادلون أهل الكِتاب إلاّ بالتي هي أحسن».
وقصارى القول فإنّ المجتمع الإسلامي فتَح السبيل إلى التعاون الحضاري بين الشعوب – مصداق قوله تعالى: «وما أرسلناك إلاّ رحمةً للعالَمين»– وأنّه هو الذي نهَج إلى النموذج الحديث، القائم على التآلف الحضاري بين «أهل الكِتاب»، جميعا، وغيرهم، ممّن كان لهُم باع في إثراء الحضارة الإنسانيّة.
وهو ما قامت عليه حضارة الأندلس؛ ومنها نهلت أوروبا، واستعانت بما أخذته، لِتقوى على إطلاق نهضتها الحضاريّة.
الشاذلي القليبي
- اكتب تعليق
- تعليق

شكرا لصاحب هذا المقال لانه اضاف الكثير للقارئ لاسيما دسامة المعلومات والتسلسل الزمني للأحداث انا باحثة ولي بعض المقالات في هذا المجال اتمنى ان تنشر لي بعض المقالات في مجلتكم مع الشكر











