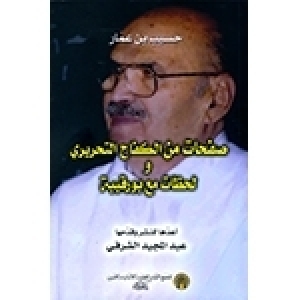عياض ابن عاشور في كتابــه الجديد: الشّاهد والمؤرّخ

 يتنقلُ الأستاذ عياض بن عاشور في كتابه الجديد «تونس: ثورة في أرض الإسلام» بين دور المؤرخ حينا وشخصية عالم الاجتماع حينا آخر، ثم يتقمّص ثوب الشاهد والإخباري حينا ثالثا، من دون أن ينسى حرفته كخبير قانوني، مُتقنا كل هذه الأدوار باقتدار. وتعكس خريطة الكتاب تلك السباحة بين التخصصات، فقد اشتمل على مقدمة لا تخلو من الطول والعمق في آن معا، ثم قسم أول عنوانه «الثورة التونسية في سياقها»، وثان عن «سينوغرافيا الثورة»، فثالث عن مفارقاتها (وهو الأطول والأهم)، وقسم رابع عنوانه «الثورة والثورة المضادة»، وخامس بعنوان «المُقايضات التاريخية للثورة»، وسادس بعنوان «قوّة القانون في الثّورة وقسم أخير بعنوان معارك من أجل الدّستور». ويمكن القول إن هذا الكتاب قصة story أو رواية، لكن الراوي يلتزم بأركان البحث العلمي فيسند كل فكرة إلى صاحبها وكل معلومة إلى مصدرها.
يتنقلُ الأستاذ عياض بن عاشور في كتابه الجديد «تونس: ثورة في أرض الإسلام» بين دور المؤرخ حينا وشخصية عالم الاجتماع حينا آخر، ثم يتقمّص ثوب الشاهد والإخباري حينا ثالثا، من دون أن ينسى حرفته كخبير قانوني، مُتقنا كل هذه الأدوار باقتدار. وتعكس خريطة الكتاب تلك السباحة بين التخصصات، فقد اشتمل على مقدمة لا تخلو من الطول والعمق في آن معا، ثم قسم أول عنوانه «الثورة التونسية في سياقها»، وثان عن «سينوغرافيا الثورة»، فثالث عن مفارقاتها (وهو الأطول والأهم)، وقسم رابع عنوانه «الثورة والثورة المضادة»، وخامس بعنوان «المُقايضات التاريخية للثورة»، وسادس بعنوان «قوّة القانون في الثّورة وقسم أخير بعنوان معارك من أجل الدّستور». ويمكن القول إن هذا الكتاب قصة story أو رواية، لكن الراوي يلتزم بأركان البحث العلمي فيسند كل فكرة إلى صاحبها وكل معلومة إلى مصدرها.
يعود الأستاذ بن عاشور إلى تفكيك مصـادر مـا اصطُلح على تسميتـه بــ «الاستثناء التونسي» في الثورات العربية، وهو ما جعله لا ينطلق من لحظة اندلاع الأحداث في سيدي بوزيد، وإنما من الخلفية الاجتماعية والثقافية والسياسية التي أحاطت بها، وجعلتها نسيجُ وحدها، فهي لا تُشبه أية ثورة سابقة، لا الفرنسية ولا الروسية ولا الصينية... ومن خصوصيات هذه الثورة أنها كانت تُبصر أمامها ما يكفي من الأسباب الشرعية لقطع رؤوس «حانت ساعة قطافها»، لكنها «لم تقطفها». في المقابل نراه ينتقدها بسبب غياب الرؤوس المفكّرة، فهي «ثورة بلا رأس» (ص19) بحسب الصورة التي اقتبسها من الباحث التونسي العربي الصديقي، نظرا لكونها استمّدت قوتها من زعامتها الذاتية. وإلى جانب قوة الدفع الرئيسية هذه، لا يُغفل المؤلف الأسباب والدوافع المباشرة، وهي مُتصلة بأنواع المعارضات المختلفة التي وقفت في وجه الاستبداد. على أن هذه الثورة لم تأت بمبادئ جديدة ولا برؤية مغايرة للإنسان والعالم، ولذلك فإن تأثيرها الفكري لم يتعولم خلافا للثورة الفرنسية والثورات اليسارية.
وهنا يتوقّف الأستاذ ابن عاشور ليؤكّد على البعد الوطني (المحلي) للثورة بعيدا عن محاولة التنظير للثورات في العالم، فهذا البُعدُ هو الوحيد المشحون بالدلالات التي تحتاج إلى توليدها. وفي مقدمتها تعدّدُ الأزمنة المتضافرة في نسيج الثورة، وسط ثقل كبير للأفكار الوافدة، التي اقتحمت الحياة والمجتمع وعالم السياسة سواء بالقوة أم بالتثاقف الناعم، ومنها تلك الفكرة المحورية التي برزت لدى مناقشة مشروع الدستور: الدولة المدنية. ويُلاحظ المؤلف أنه حتى المناهضين لها لم يتمالكوا عن دخول حلبة الجدل والصراع حولها قبل أن تجد طريقها للإدراج في الدستور. بهذا المعنى وبمعان أخرى شرحها الكتاب، يمكن القول مع الدكتور مولدي الأحمر إن الثورة التونسية ليست قومية ولا برجوازية ولا بروليتارية ولا هي ثورة فلاحين ولا ثورة دينية، فهي تأبى تصنيفها ضمن «الكاتالوغ» الرسمي للثورات.
ثورة غير مُعولمة
الحديث عن التصنيف يقودنا إلى التطرُّق للمنوال المرجعي الذي يعتمده الكتاب، فهو يتميّز بغزارة المراجع وتنوّعها وخصوبتها، بين أنكلوسكسونية وفرانكوفونية وعربية، إذ لا تخلو صفحة من مرجعين أو ثلاثة. غير أن المثال الفرنسي ظل هو المنوال النموذجي أو وحدة القياس للحكم على الثورة التونسية، من دون الإشارة إلى الثورات الديمقراطية في أوروبا الشرقية والوسطى، مثلا، التي كانت أقرب إلينا. من هنا استند المؤلف في تحديد الخط الفاصل بين الانتفاضة والثورة إلى ما شهدته الثورة الفرنسية من نقلة بعد لحظة السيطرة على سجن الباستيل، «وهذا تقريبا ما حصل في تونس» كما قال (ص70). كما أنّ اعتبار ثورة الحرية والكرامة بمثابة ثورة 89 عربية (اختصارٌ للثورة الفرنسية التي حدثت في 1789) مثلما وصفها بنجامين ستورا يندرج أيضا في نسق المركزية الفرنسية. ومن هذه الزاوية كنا ننتظر من المؤلف أن يدحض فكرة مارتن مالتا الذي اعتبر أن «المفهوم العصري للثورة يُحيل على ظاهرة أوروبية بامتياز، مهما كان هذا الرأي ظالما لباقي الإنسانية» (ص 40).
كلُ هذا لا يُقلّل طبعا من عمق التحليل الذي أبرز العلاقة بين الظاهرة الثورية والدين من ناحية وبينها وبين القانون من ناحية ثانية، و«هما المسألتان اللّتان وجدنا أنفسنا نُجابههما وجها لوجه بعد الثورة» كما يقول المؤلف. وبعدما يستعرض تعريفات الثورة وشروط قيامها (ص69-67) يُقدّم لنا ردّا منهجيا على بعض المقولات البائدة التي كانت تزعم قبل اندلاع الثورات في 2011، أن المجتمعات العربية خاضعة وخانعة وأنّ الاستبداد يستفحل في العالم العربي وسط عالم ينخرط أكثر فأكثر في الديمقراطية، وهو ما يُسمّونه «الاستثناء العربي». وهو يتبنّى في هذا الصدد قولة جان بيار فيليو «إنّ الاستثناء العربي الوحيد حقّا يكمن في السرعة التي كنست بها انتفاضة ديمقراطية نظاما ثم فعلت الشيء نفسه بالنظام الثاني» (ص55).
هؤلاء سبقونا
إلا أنّ القول بأنّ الثورة التونسية هي «أوّل ثورة في العالم العربي من أجل الحريّة» غير دقيق، إذ لا ننسى الثورة الشعبية الكبرى في السودان سنة 1964، التي أطاحت بالمشير ابراهيم عبّود وأرست نظاما ديمقراطيا، ثم الثورة الثانية التي تلتها في أفريل 1985 وأطاحت بجعفر النميري وأقامت حكما مدنيا تعدّديا، قبل أن ينقلب عليه «الإخوان المسلمون» بعد سنتين.
وبالعودة إلى جذور الانتفاضة في تونس يُشير الأستاذ ابن عاشور إلى أنّ نسبة الانخراط في حزب «التجمع» الحاكم كانت الأعلى في ولاية سيدي بوزيد، لكن كثيرا من هؤلاء المنتسبين شاركوا في المظاهرات ما يدُلُ على هشاشة النظام (ص72). ويستعرض أدوار القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة، فيصف موقف قيادة اتحاد الشغل من الاحتجاجات بالحذر الشديد، ويومئُ إلى أنّه لم يؤيد مظاهرة 14 جانفي في العاصمة، التي كان شعارها «بن علي ارحل» (ص75). كما يستعرض دور الشباب الفيسبوكيين في الترويج السريع لصور الاحتجاجات، وخاصة علي بوعزيزي الذي نقل إلى العالم عبر قناتي «فرنسا24» و»الجزيرة» اندلاع الانتفاضة في سيدي بوزيد. غير أنّ المؤلف لم يُشر إلى أنه عضو قيادي في حزب معارض لعب دورا بارزا في مظاهرات القصرين وسيدي بوزيد والعاصمة.
الشاهد والإخباري
انطلاقا من القســـم الثالث يستعير ابن عـــاشور الإخبـــاري مــن ابن عاشور الشاهد بعضا من الوقائع التي عاشها بعد الثورة، ليشرح لنا ديناميات الانتقال السلس والسلمي من حكومة الغنوشي إلى حكومة قائد السبسي، وخاصة التجاذبات المريرة في الهيأة العليا لتحقيق أهداف الثورة (التي كان هو على رأسها)، قبل الاتّفاق على تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي من 24 جويلية إلى 23 أكتوبر 2011. وهو يبوح لنا بسرّ مفاده أنه كان يُدوّن في مفكّرة خاصة أهم الأحداث والاجتماعات في الهيأة العليا، ممّا أفاده كثيرا اليوم في تأليف الكتاب ومنح القرّاء معلومات غير منشورة عن تلك الفترة. بيد أنّه لا يتوقّف عند دور الإخباري، وإنما يُحلّل المحطات الكبرى التي مرّت بها الثورة، ومنها التوافقات أو المقايضات التاريخية حول الشرعية، وإن لم تحُل دون اقتحام العنف للمجال السياسي، «فالصراعات حول الشرعية داخل الثورة تُحلّ في غالب الأوقات بواسطة العنف» كما قال (ص217). وحظي الاتفاق على خريطة الطريق للمسار الانتقالي، الذي وافقت عليه قيادات الأحزاب (عدا «المؤتمر») في 15 سبتمبر 2011 بحيّز مهمّ من القسم الخامس من الكتاب، بوصفه نواة للتوافق على الدستور وعلى مهمة المجلس التأسيسي. واعتبر المؤلف دستور 2014 استئنافا للمسار الدستوري المُتجذّر في الثقافة السياسية التونسية، «على نحو جعل مفهوم إرادة الشعب والكرامة والحرية والمواطنة والحدّ من السلطة تُحيل على مضامين دقيقة للشرعية الديمقراطية الدستورية (ص 251)». واستعرض بإسهاب في القسم الأخير من الكتاب المعارك التي جرت حول صياغة الدستور بين التيار المتمسّك بمدنية الدولة والتيار الذي سعى إلى جعل الشريعة ليس فقط مصدر التشريع في المجلس التأسيسي، وإنّما أيضا «المرجع الذي سيستمد منه المجلس (التأسيسي) القوانين والمؤسسات القضائية والتربوية والاجتماعية والسياسية» (تصريح للنائب صادق شورو لإحدى القنوات التليفزيونية).
«ثورة من أجل دستور؟ أليس هذا رهانا خاسرا؟» يتساءل الأستاذ ابن عاشور في خاتمة الكتاب: لماذا كل هذه الجهود والمخاطر والوقت والتضحيات من أجل وضع دستور نعلم جميعا مسبّقا حدوده ونزواته؟ وجوابه أن تكوين فكرة صادقة عن اللحظة الثورية لا تكون بنظرة تستبطن الأزمات التي تعقب كل ثورة طيلة سنوات، فعندئذ سنصل بالتأكيد إلى استنتاجات تلخّصها عبارات من نوع «الثورة المسروقة» و«الثورة الضائعة» أو المخطوفة أو المغدور بها... ويُشدّد المؤلف هنا على أنّ المناقشات التي رافقت كتابة الدستور شكلت أفضل اختبار لممارسة المواطنة، وهي بهذا المعنى تمهّد الطريق لوضع الدستور نفسه موضع التنفيذ، فالمعركة الديمقراطية التي لا تقل أهميّة عن الثورة ذاتها، هي أفضل مُبشّر بالديمقراطية» (ص354).
رشيد خشانة
- اكتب تعليق
- تعليق

.jpg)