د. احميده النيفر: فــــي الثـــورة والثـقافـــة المعطــوبــــــة
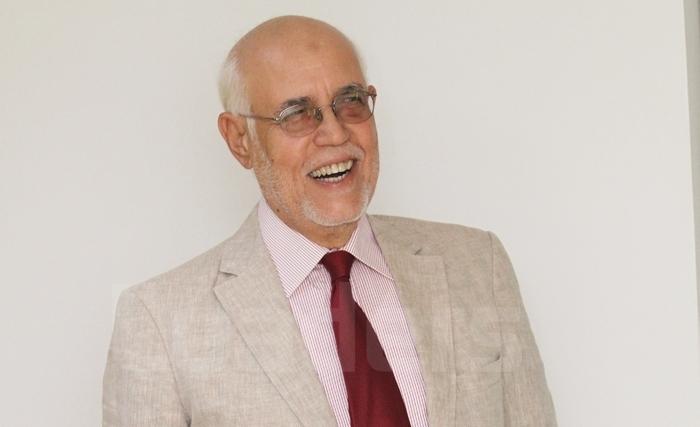
1 - في أول نشاط غير قتالي لخليفة عثماني خارجَ حدود مملكته اتجه السلطان عبد العزيز سنة 1867 صوب مدينة باريس ليحضر المعرض الدولي العام بها. لم يتردد معارضوه المتربّصون به في استغلال زيارته فاستصدروا فتوى بعزله. كان مستندهم في فتوى العزل هو تشويش السلطان للأمور الدينية والدنيوية ممّا أضرّ بالشؤون السياسية.
هي حادثة مفصلية لها أكثر من دلالة. أبرز جوانبها وزنُها الحضاري الذي يتيح الوقوف للحاكم المسلم متصديا له بالعزل لمؤاخذات منها سفرٌ استثنائي إلى بلد غير مسلم بما شوّش أمور الدين والدنيا. أساس المؤاخذة وجود قطيعة باتّة بين عالَم المسلم والعالم الآخر وأن الزيارة انتهكت قاعدةَ هذا التصوّر الإيديولوجي للعالم.
تستمدّ جذورُ هذه المؤاخذة قوتَها من رؤيةٍ تستبطن فكرة الاستقطاب الثنائي بين المسلمين والمختلفين عنهم في الواقع السياسي والقانوني والأخلاقي وكذا في التبادل الفكري والاقتصادي مما لا يسمح بقيام أية علاقة بين العالَمَيْن خارج مجال الحرب. هو بناء ثقافي مغلق على الذات لا تُحتمَل فيه صِلاتٌ خارج مجال التنافي بحيث تنهدم كل الجسور وينعدم كل تواصل وتعارف إنسانيين.
اللافت أنّ هذه الرؤية السكونية المسكونة بالخوف الحضاري والانغلاق الثقافي التي اسقطت السلطان عبد العزيز منذ ما يزيد عن قرن ونصف لا تزال قابعة في عالمنا العربي وقادرة على الفعل والإقصاء رغم غروب السلاطين وتغيّر الظروف وتحوّل السياق في كافة الأوطان.
2 - في هـذا العــام الســادس لذكرى انــــدلاع أحداث 17 ديسمبر 2010 ـ 14 جانفي 2011 الثورية التي بزغت في تونس سنة 2011 تكشّفت معضلة هذا العالَم بوجهيها: وجهٌ مشرق واعد عبّرتْ عنه أحداث المخاض التغييري بما فيه من تصميم وطاقات وآفاق ووجهٌ كالح تعرّت فيه الإعاقات والهنات بصورة مأساوية مكّّنت لخيبة أمل وإحباط واسعيْن.
انتشارا للشرارة التي أوقدها محمد البوعزيزي بجسده يوم 17 ديسمبر 2010 احتجاجا على ما سُلط عليه من تعسف جهر الجمهورُ بكل المكبوت الذي ما فتئت الأجيال تنطق به مطالبة بالحرية والكرامة. وإذا كـــان معظم النار من مستصغر الشــرر فإن شرارة البوعزيزي استطاعت منذ اتقادها أن تَسْتَعِر فتضيء جنبات عالم عربي متوثب رغم القهر والاختراق. لهذا لا مناص للباحث المتأمل أن يشتغل على أكثر من قضية خطيرة استجلاءً لما وقع استصغاره والاستهانة به من كبريات الأسئلة.
يتصل أول الأسئلة بإشكالية «الهوية والحدود» التي ما تزال تقضُّ المضاجع رغم أنها ساهمت بقــوة في الإطاحـــة بحكــم السلطان عبد العزيز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبمن انتصب بعده مستبدّا أو غازيا. يتعلق صميم المسألة وطنيا وعربيا بموقف يتأرجح بين الاكتفاء بالدفاع عن الهويّة خوفا عليها وبين تهميشها والاستهانة بها. في هذا انزلقت نخبٌ عربية وقسم من مجتمعاتها في الفترة الحديثة والمعاصرة رغم أنه موقف مغايرٌ وقاطعٌ مع سُــنَّـة ثقافية ميّزت حياة العرب - المسلمين عند بنائهم لحضارتهم بوعيهم لذاتهم في علاقتها بالآخر.
ما غدا عندنا اليوم إشكالا للهوية والحدود إنما هو استعادة غير مبرّرة لمفهوم فقهي وموقف حضاري يرتبطان بـمقولة «دار الإسلام» و«دار الحرب». هذا ما يؤكد ضرورة مراجعة القضية بصورة جذرية لما لها من تداعيات مأساوية نشاهد جانبا منها اليوم فيما يصنعه المتربصون بمستقبل الأوطان العربية وإمكانات صعودها.
3 - الدقيق في مراجعة هذه الإشكالية هو التباين القائم بين الفضاء العربي والأوروبي الغربي في مجالي الوعي السياسي والحريات العامة وفي خلفيتهما الثقافية. هما فضاءان متجاوران لا يفصل بينهما جغرافيا سوى البحر المتوسط. لكن المفارقة الكامنة وراء هذا التباين هو أن الجهود المبذولة لتأكيد الحدود الفاصلة بين الفضاءين، أمنيا وسياسيا، انتهت إلى ما يشبه الحرث في البحر. فلا جانبٌ من شباب جنوب المتوسط أقلع عن حلم اقتحام أوروبا مهما كلّفه الثمن ولا استطاعت سياسات قادة أوروبا أن تجعل من قارتهم قلعةً منيعة في وجه موجات المتسللين واللاجئين. هنا باءت مساعي بناء حداثة حقيقية بالتلاشي وهناك لم يصمد الحصن المتعالي عن بؤس عالَمها المجاور رغم تناسيه زعمَه «التحضيري» له.
يضاف إلى هذا عجزٌ مزدوج يفاقم تعقيدَ مسألة الهوية والحدود. هناك من جهة إخفاق واضح للسياسات الأوروبية الحالية خاصة عن حسم مسألة المعايير الثقافية والسياسية المعتمدة لإرساء تعاونها مع أجوار شرق المتوسط وجنوبه. يقابل هذا الجانب عدم توفُّق النخب العربية الحاكمة والمفكرة في إرساء مشروع وطني جامع بوعي إِلافِـيٍّ لمجتمع تضامني بما أبقى الهوّة شاسعة، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، بين الأقطار العربية وبينها وبين بلدان الشمال.
لذلك فلا غرابة إن وقع إفراغ المشروع الأوروبي: «الاتحاد الأوروبي من أجل المتوسط» من مضامينه الإيجابية بما ألحقه بمصير مشاريع أخرى سابقة لم تستطع أن تعالج معضلة الحدود بكل معانيهَا.
4 - يتّصل مفهوم الحدود بمعنى قريب دالٍّ على التحديدات الجغرافية السياسية المُثبَتَة على الخرائط وضمن الاتفاقيات الدولية والفاصلة بين الدول والأقطار في قوانينها وأعرافها وسياستها ونظمها. تلك هي معالم الجانب الظاهر للحدود، إلى جانبه توجد حدود أخرى وازنة رغم أنها غير مُعلنة وهي في حركة دائمة وفي حالة تجاذب مع الأولى. تختلف الثانية عن نظيرتها في الطبيعة والفعل فتكون أحيانا لصيقة بها كما تكون غالبا متعالية عنها، متحررة منها أو متجاوزة لها منتظمةً في كل ذلك أذهانَ الأفراد ومشاعر الجماعات. هي حدود تعبّر عنها الثقافةُ في طبيعتها التصوّريّة التي يختارها الناس فينساقون إليها ويَحْــيَون بها ويستمدون منها جانبا هامّا من عواطفهم ومواقفهم لِحمولتها الرمزية والعقدية والقيمية ووزنهاالفكري والسياسي-الاجتماعي العملي. من ازدواج هذين البعدين للحدود: التوطُّني الجغرافي والتصوّري الاختياري، تقوم الهويّة وتتحدّد الانتماءات في الرؤية التنميطية المسارعة إلى تمجيد الذات و استهجان الآخر أو في فاعليتها المنفتحة - الحوارية والبنائية.
إشكال الحدود في أن قسمها البارز الجغرافي ينحو إلى الثبات بينما قسمها الثقافي الخفي أبلغ تأثيرا في صياغة الهوية لكونها عنصرا مركَّبا من ناحية وفي حالة تَشَكُّلٍ دائمٍ من ناحية ثانية.
كيف يتمّ التراشح بين الثابت والمتحوّل، بين البسيط والمركَّب؟ و ما العمل لتنظيم علاقتهما وتطويرها خاصة في ظروف تتميّز بتسارع التحولات الدولية وعنفها؟
5 - للإجابة يتأكد طرح الوجه الآخر للسؤال المتمم لإشكالية الهوية والحدود والمتصل بثنائية الثورة والثقافة.
ما تفيدنا به السنوات الستّ الماضية في تونس أنّ الحدث الثوري الذي حصل لم يكن انفجار نظام اجتماعي سياسي قائم فَقَد مقومات الحياة وشرعية الوجود فحسب. الإعاقة الخفية التي وقع التغاضي عنها في فهم ما حصل وما تتواصل مفاعيله في السنوات الست التي انقضت وثيقةُ الصلة بالثقافة المعطوبة التي تزهق الأعمار وتزرع الدمار.
بهذا المعنى لم تقم الثورة، في تونس وخارجها، إلا لتوفر شرطَيْن: نظامٌ اجتماعي سياسي فاسد تعضده عَطوبة ثقافية لم تقدر على فهم ما كان يجري فضلا عن أن تأخذ على عاتقها تطوير المجتمع وتحرير الفرد فيه.
ذلك أن شعار اسقاط النظام لم يكن معناه في المسعى التغييري للثورة الانتفاضَ على النظام السياسي الاجتماعي وحده. لقد كان في ذات الوقت مطالبة بالخروج على منظومة مغلقة ومهمشة من المعارف والمعتقدات والفنون والأخلاق التي ارتكن إليها النظام المدان.
لهذا فإن تحدّي الثورة واتساع مسيرتها مرتَهِنٌ في جانب رئيسي منه بتجاوز ثقافة التكلّس والتلهية المولدين للعنف واللامبالاة ذلك بازدهار ثقافة مبدعة لحلول وتعبيرات وتقنيات جديدة أي بقدر ما تكون ثقافةً حيّة مستجيبــــة لمطــــالب المجتمع وتطلّعاته ومتمثلة لأشواق الفرد وطموحـه وواعية بمقتضيات زمنهما الحضاري.
د. احميده النيفر
رئيس رابطة تونس للثقافة والتعدّد
- اكتب تعليق
- تعليق

.jpg)









