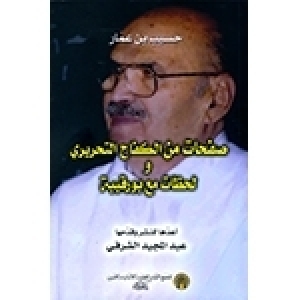ثــــــورة مقطــــوعــة الرأس؟

يُسميها البعض «ثورة بلا قيادة» ويصفها البعض الآخر بـ«الثورة اليتيمة»، ويُطلق عليها آخرون «ثورة العاطلين والمُهمشين». لكن الجميع يُفاخرون بأنها ثورة Made in Tunisia فهي لم تُقلد أي أنموذج ولم تستورد أي شعار من شعاراتها ولم تقتبس شيئا من كتب الثورات. وهذا يعني أنها لم تكن بلا رأس، بل ويدل على أنها استندت على إرث خصيب لم يُتح لسواها من ثورات «الربيع العربي»، ما جعلها تنجو من المطبات التي وقعت فيها ثورات أخرى.
صحيح أن الثورة التونسية لم تكن لها قيادة سياسية مركزية تُوجه مسارها وتُحدد لها المطالب وتصوغ الشعارات، غير أن المسيرات واالإضرابات والاعتصامات والمواجهات الشارعية، طيلة قرابة الشهر، كانت تقودها مجموعات محلية من الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية التي تشبعت بالفكرة الديمقراطية. وهذا ما غفلت عنه بعض الدراسات التي تناولت سياقات الثورة بالتحليل فأتت نظرتها حولاء. وأذكر في هذا الصدد أن أحد المؤرخين قدم «بحثا» في أول ندوة علمية عن الثورة التونسية في مارس 2011 تناول فيه مواقف الأحزاب السياسية من اندلاع الانتفاضة، فإذا به يُقدّم قراءة لبيانات الأحزاب على شبكة الانترنت ليستخلص أن هناك أحزابا أكثر راديكالية من أحزاب أخرى ! من دون أن يرصد الدور الحقيقي لكل حزب في الميدان.
ومن الإجحاف في حق القوى السياسية والاجتماعية التي لعبت دورا في التهيئة لمنعطف 14 جانفي إنكارُ ذاك الدور أو التهوينُ من مساهمتها في تأطير الجماهير، التي كانت تتسم بمستوى وعي متقدم لا يُشكك فيه أحد. أما القول بأن ثورتنا جاءت مُطابقة للتوصيف الذي وضعه المؤرخ البريطاني إيريك هوبزباوم للثورة الفرنسية (1789) فهو كلام يحتاج إلى تدقيق. قال هوبزباوم في كتاب «عصر الثورة»: «لم تحدث الثورة الفرنسية على أيدي حزب أو حركة قائمة بالمعنى الحديث للكلمة، ولم يتزعمها رجال يُحاولون تنفيذ برنامج منظم، بل إنها لم تطرح «قيادات» من النوع الذي عودتنا عليه ثورات القرن العشرين» *.
وهذا يعني أولا أن من عادات الثورات في القرن العشرين أن «يتزعمها رجالٌ يُنفذون برنامجا مُنظما»، ولا شيء يُجيز وضع الثورة التونسية خارج تلك المسارات أو على هامشها. وثانيا إن التأكيد بأن «هذا التوصيف يتطابق تطابقا تاما مع الحالة التونسية» لا يسنده الواقع الميداني الذي عاشته مختلف الجهات قبل 17 ديسمبر 2010 وبعده. فإذا ما انطلقنا من الدائرة التي أبصرت الشرارة الأولى للاحتجاجات، أي سيدي بوزيد والقصرين، سنُلاحظ أنهما من أكثر المناطق التي «حرثتها» الأحزاب الديمقراطية طيلة ما لا يقل عن ثلاثة عقود. وبرغم اختلاف مراحل المدِّ والإنحسار ظلَّ مستوى التأطير السياسي فيها أعلى من كثير من المناطق الأخرى. وكم نحن بحاجة إلى أبحاث علمية ميدانية لاستجلاء هذا الأمر.
أما الدائرة الثانية وهي الأوسع وتشمل الولايات التي انتقلت إليها الانتفاضة، فمعلوم أن التي تصدرت الاحتجاجات فيها نُخبٌ سياسية ونقابية من كل الأطياف. وهذا يحتاج بدوره إلى تسليط الضوء عليه سوسيولوجيًّا. بهذا المعنى تتفكك الصورة الخاطئة التي روَّجتها بعض الأوساط بكثافة، لتبرير استقالتها، من أن الثورة تجاوزت كل الأطر الحزبية والاجتماعية. ويكفي للتدليل على تهافت تلك القراءة النظرُ في تركيبة النواة التي تجندت يوم 17 ديسمبر لقيادة الاحتجاجات في سيدي بوزيد، وهي نواة مؤلفة من مناضلين معروفين أفنوا سنوات في الأحزاب الديمقراطية، وكان على علماء الاجتماع أن يدرسوا هذه العينة بدءا من مسارات تكوينها إلى نوعية ثقافتها السياسية والنقابية إلى علاقتها بعموم الناس الذين انتفضوا في ذلك اليوم. ولعل هذا ما أشار إليه كتاب «الثورة التونسية: القادح المحلي تحت مجهر العلوم الإنسانية» حين قال «إن البحث بيَّن أن القوى المحلية التي فجرت الاحتجاجات في سيدي بوزيد والقصرين تشترك من خلال مطالبها وسلوكها السياسي مع النخب الثقافية والاجتماعية الحضرية العريقة في نفس الخصائص والقيم والتصورات، وهذا أمر بالغ الجدة من الناحية السوسيولوجية التاريخية» (ص6).
وإذا كان الأمر على هذه الدرجة من الجدة والتميُّز، فلماذا الرجوع دوما إلى الثورة الفرنسية بوصفها «مرجعا عالميا نموذجيا تُقاس به الثورات التي تلتها»؟ إن ميزة الثورة التونسية أن القوى الاجتماعية التي وجدت نفسها، ميدانيا، على رأس الاحتجاجات حاملةٌ لمشروع عام هو خُلاصة ربع قرن من عمل الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المستقلة والاطارات النقابية. وقد أصاب الكتاب المذكور حين ربط انتفاضة 17 ديسمبر بانتفاضة الحوض المنجمي «حيثُ تشكلت لأول مرة نخبة قيادية محلية تقود المظاهرات وتدخل السجن ولا ينجح النظام في عزلها عن محيطها الشعبي». وأزعم أن الدراسة السوسيولوجية للنخب المحلية، التي قادت الاحتجاجات في مختلف المدن، ستُثبت فرضية أن تلك القيادات الجهوية والمحلية هي الابن الحقيقي للمشروع الحداثي، بروافده الستة، وهي أولا الدور التاريخي لأحزاب المُعارضة الجادة في غرس الفكرة الديمقراطية على مدى ما لا يقل عن ثلاثة عقود، وثانيا دور النقابات في نشر ثقافة الحقوق، ومن ضمنها الحق في العمل والكرامة، وثالثا دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ورابعا دور الصحافة المعارضة والمستقلة (حقا) في إشاعة فكرة المواطنة ونقد الانحراف الاستبدادي للحكم، وخامسا النفس الإصلاحي داخل الدولة، الذي لم ينقطع منذ عهد الوزير الأكبر خير الدين في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، وسادسا تمرد الشباب الذي وظف ثورة المعلومات بنجاح، فاستطاع كسر أسوار الرقابة والقفز على كل الموانع البوليسية التي وُضعت في طريقه.
لاريب في أن الثورة التونسية كانت ثمرة لتلك العناصر مُجتمعة، والتي شكل تداخلها وتفاعلها مشروعا ديمقراطيا، الحُرية مبناه والكرامة مُبتغاهُ. بهذا المعنى هو مشروع أصيلٌ ونسيجُ وحده، لا يُشبه المسارات التي شهدتها البلاد العربية الأخرى. لذا فهو يحتاج إلى دراسات علمية ميدانية لاستنطاق دواخله واستجلاء غوامضِهِ التي لم تصل إليها بعدُ أيدي الباحثين.
(*) مقدمة كتاب «الثورة التونسية: القادح المحلي تحت مجهر العلوم الإنسانية» (مجموعة مؤلفين بإشراف الأستاذ مولدي الأحمر) الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة 2014.
رشيد خشانة
- اكتب تعليق
- تعليق