مختار اللواتي: كيفما تكون الدولة، يكون المواطنون !
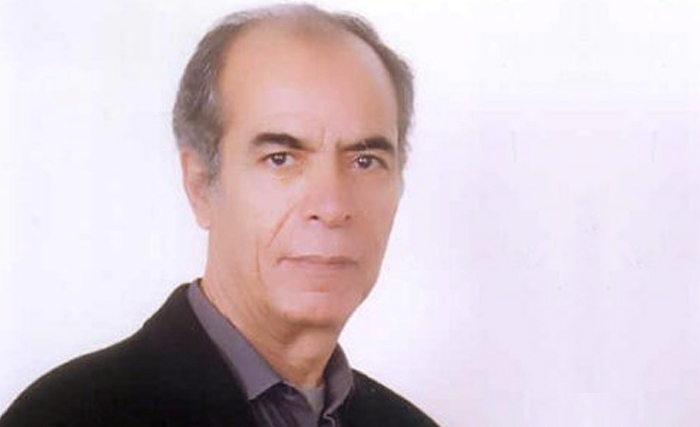
قد يكون السؤال استفزازيا وأكثر من إنكاري، لو قلت لكم، هل شعرتم بالدوار وأنتم تتابعون تصاريح وتعاليق الساسة البهلوانيين والإعلاميين المساكين المرتبطة بمنعرجات المواقف بشأن تشكيل الحكومة؟ فبين الاشتراط والتشاور والرفض والوساطة والعودة إلى التشاور من جديد، رأيتم، ومازلتم ترون، الأعاجيب في انقلاب المواقف وتبدل التحاليل والتفاسير.. وقد كنتم عشتم أياما وأسابيع شبيهة مع رحلة التشكيل السابقة للحكومة التي آلت إلى السقوط قبل أن تولد..
دعكم من صراعات الديكة هذا. فهو يسبب فعلا الصداع إلى حد الدوار. كما إنه ليس جديدا ولا هو وليد مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، سوى في الشكل. هكذا كان الأمر، بل أدهى وأخطر، طيلة السنوات التسع الماضيات. ويكفي أن تعودوا إلى الإحصائات، ولو التقريبية، عن أعداد المرضى النفسيين المتصاعدة، والإرتفاع غير المسبوق لنسب حالات الطلاق والانتحاربين الشباب وحتى اليافعين منهم والأطفال، وأفواج الخبرات الفارة من البلد في نزيف مازال مستمرا ومنذرا بكل المخاطر، والانتشار المخيف للمتسولات والمتسولين في مختلف مدن البلاد. كل هذا، زيادة على المعاناة اليومية لغالبية العائلات من الغلاء الفاحش المتصاعد لمعيشتها اليومية وعجزها عن تأمينها مهما تحايلت، سيجعلكم تضربون كفا بكف وأنتم ترددون في شبه هذيان، "ماذا فعلنا من سوء ليصيبنا هذا البلاء؟"
إنّ بعضنا، حتى لا أقول كثيرين من أبناء الشعب الطيبين غير الملوَثين بالسياسة، أصبحوا يتهامسون بأنّ ويلات هذه السنوات العجاف الضنكة أدهى وأمر من السنوات التي سبقتها. بل إنّهم لايترددون في القول إنّ عيشتهم كانت هانئة وحياتهم كانت آمنة ومؤَمَنَة إزاء غوائل الدهر، في تلك السنوات الغابرة!
أعرف أنّ هناك من الأصدقاء من قد يلومني على هذا الكلام الذي قد يعتبرونه تمجيدا، مبطنا أو مكشوفا، لاستبداد العهد السابق.. ليس لي مشكلة، مادمتُ أنقل حقائق يعرفها جيدا ذوو البصائر الثاقبة.. المهم عندي هو دق نواقيس الخطر من جديد بعد أن بلغ السيل الزُبى !. فقد كنت أطنبت في مقال نشرته منذ سنة تقريبا في تبيان دهاء ومهارة حركة النهضة وبالأساس رئيسها راشد الغنوشي، في المناورة السياسية والسياسوية معاً. وختمت المقال بالتحذير من عواقب الأمور إذا لم يلم التقدميون والديمقراطيون الاجتماعيون الحداثيون شملهم ويشكلوا جبهة عريضة ببرنامج دقيق وخطة مضبوطة لإنقاذ البلاد من الأفعى الفاتحة فاها أمامها لابتلاعها. فماذا كان رد الفعل وماذا كانت النتيجة؟؟ لقد شك أحد الأصدقاء في نواياي واتهمني بأنني قد كلّلت رأس زعيم حركة النهضة بالزهور بتعداد خصاله. وتساءل عن المقابل الذي أنتظره من وراء ذلك!.. أما عن النتيجة في الصفوف "التقدمية والديمقراطية"، فكان أن أنقسمت الجبهة الشعبية إلى جبهتين، خاضت االإنتخابات الأخيرة كذلك، فجنت الخسران. ومن 15 مقعدا في الدورة الماضية لمجلس النواب، لم يَنجُ في الانتخابات التشريعية المنقضية إلا مقعدٌ يتيمٌ واحدٌ بجهد صاحبه. أما بقية الأحزاب المنسوبة على الحداثة والدولة المدنية، فلم تخرج إلا بالفتات وبمزيد الاختلاف والانقسام، باستثناء حزبين جديدين لم يمض على تأسيسهما وقت طويل، وقد وقفا بندية لاغبار عليها في وجه الإسلام السياسي، بنهضته وائتلاف كرامته ورحمته وبقية الروافد المخفية منه. ولولا التعجيل بالزج برئيس أحدهما وباعثه في السجن على طريقة الخطف المافيوزي بتعلة ثقل ملفات فساده المركونة على الرف لسنوات، بعد أن فشلت محاولة سن قانون على المقاس يُلحَق بالقانون الانتخابي، لمنعه من التقدم إلى الانتخابات، تشريعية كانت أو رئاسية، ولولا تلك الحملة الشعواء ضده، بكل الأساليب المشروعة والباطلة على حد سواء، لكان على الأرجح قد تصدر ذلك الحزب نتائج الانتخابات. أو على الأقل لكان كتفا لكتف مع نتيجة حركة النهضة. أما الحزب الثاني فهو الخارج من منطقة "الحجرالصحي السياسي" كمارِدٍ انفلت من قمقمه بقيادة رئيسة حازت كثيرا من الصفات المطلوبة للقادة السياسيين، من جرأةٍ ووضوحِ رؤية وثباتٍ على المبدأ في الإختيارات التي رسمتها، بقطع النظر عن صدقها من عدمه. فنشرت الرعب في أوساط خصومها، غلفوه بالإستهجان والاستخفاف والاتكاء على حجة بُنُوَتِها من النظام البنعلي وسعيِها إلى إعادة الاستبداد. لقد خاضت المعارك بلا هوادة منذ ظهورها اللافت أثناء محاكمة حزبها الأصلي، "التجمع الدستوري الديمقراطي"، تلك المحاكمة الغبية بكل المقاييس والتي انتهت بحلّ ذلك الحزب، وإلى اليوم. فقد انتشر كثيرون من سياسيي ورموز التجمع ذاك في أحزاب عدة بعد أن انفرط عقد حركة "نداء تونس" التي آوتهم وعديد الوجوه النقابية والديمقراطية. أما هي فقد اختارت أن يكون لها حزب متفرد قائم بذاته، متفادية اللغط حول الرئيس الذي كانت وفية له وللحزب الذي أصبح من الماضي، فتظللت بالإرث البورقيبي وبالحركة الدستورية زمن ازدهارها على يدي الزعيم الحبيب بورقيبة ورفاقه، واستلهمت منها تسمية حزبها الوليد. فمن انكب على درس هذه الظاهرة، إن صحت تسميتها كذلك، وعلى مسار هذه المرأة، منذ ذلك التاريخ وإلى الآن، وتوقع الآتي؟؟ اذكر أنني وزعتُ في الفضاء الأزرق مداخلتَها في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب الجديد لمناقشة ميزانية الدولة لعام 2020، والتي كانت مداخلة في غاية التركيز والموضوعية، وتُعَدُ نموذجا لما يمكن أن تكون عليه مداخلاتُ أعضاء مجلس النواب، فعلقت إحدى الصديقات على مافعلْتُ، بالقول "ماهذا يا مختار" في تلميح لما عساي أنويه من تقرب، ربما تراه تلك الصديقة، من ذلك الحزب هذه المرة !! وعندما أحال لي أحد الأصدقاء مداخلة أخرى لها كانت في جلسة مناقشة اتفاقات تعاون مختلفة، فيها الجديدة وفيها التي تعود إلى ثلاث سنوات مضت دون أن تُعرض على المجلس في دورته الماضية، وجدتُ في تلك المداخلة كذلك من العمق والجدية والحرفية في التفكيك والنقد وكشف ماتخفيه أحدثُ تلك الاتفاقيات من مزالق ومخاطر على السيادة الوطنية، ما يرقى إلى أعلى المستويات لدور نائب الشعب.. ولكني عدلت عن التوزيع هذه المرة تفاديا لوجع الدماغ من ناحية، وليقيني شبه التام، أنّ الجميع مستسلم لمسلماته ولأحكامه ومرتاح لغيبوبته الفكرية من دون "حشيش".. أما الدرس والتحليل، فقليلون هم المهتمون بهما.. وللعلم، لمن لايعلم، أنني لم أحمل يوما بطاقة انتماء لا "للحزب الإشتراكي الدستوري" في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة، ولا "للتجمع الدستوري الديمقراطي" في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. بل إنّ مساحي الحيوي كان دائما ودون انتماء تنظيمي، اليسار إجمالا والوسط الديمقراطي عموما. وأنٰ انتمائي الوحيد في العهد البورقيبي كان للاتحاد العام التونسي للشغل. وفي هياكله خضت أشرس المعارك النضالية من أجل الديمقراطية وحماية السيادة الوطنية وفك ارتباط المنظمة الشغيلة بالحزب الحاكم، والاستقلال عن جميع الأحزاب، مع الدفاع عن حق المواطنين في التنظم وفي حرية التعبير. وقد دفعت ضريبة هذا النضال سجنا وحرمانا من حسبان سنوات الطرد مع زملائي من الشغل في جراية التقاعد إلى اليوم، دون ذرة ندم عما فعلت. وهي مبادئي التي مازلت أدافع عنها بقدر ما أستطيع.
لذلك أخذ مني الإحباط كل مأخذ في الأشهر القليلة الماضية، وفقدت كل رغبةٍ ودافعٍ إلى الكتابة أو حضور أي مناسبة، وخاصة تلك التي تقام في ذكرى تلك اّلإغتيالات التي اختطفت منا بعضا من خيرة مناضلي هذا الوطن بأيدي أعدائه، أعداءِ الإنسانية وأعداءِ رموزِ الحرية. لأن تلك المناسبات أصبحت لي مصدر ألم أمام لا العجز فحسب على تعديل المسار وإقرار العدل والإنصاف حتى يسترد المواطنون أنفاسهم فيزيحوا عن صدورهم ما جثم عليها من ظلم وهوان، بل خاصة هو السؤال الذي يراودني ويؤرقني على الدوام، متى لهذا الشعب أن يستفيق مادامت نخبه قد راقها ماهي فيه من مهاترات، يتقن حبكتها من يكنون للدولة الوطنية المدنية كل العداء ويمضون في دك أعمدتها الواحد تلو الآخر بعزم وتصميم ودهاء لايفتر؟.. ولعل تجويع الشعب وتخويفه باستمرار ببعبع الإرهاب، إضافة إلى نشر الفساد وحماية المفسدين، وتقويض أركان الاقتصاد الوطني، والإمعان في التضليل كحال الذئاب، بشعار التوافق والوحدة الوطنية التي هم أول الساعين إلى تفتيتها، ماهي إلا إشارات لما يتهدد هذا البلد من أخطار ماحقة أخرى قادمة..
يدهشني بعض الأصدقاء عندما يدعون المواطنين إلى القيام بواجباتهم، والتحلي بالضمير في ذلك، والتآزر وما إلى ذلك من نداءات الوعظ والإرشاد.. وكأنهم لا يعلمون أنّ ذلك من أصعب الأمور، مادام من يعتلون أعلى المراتب والمناصب في الدولة، ضالعين في الفساد في الوقت الذي يتبجحون فيه بمحاربته. بل هم يقومون بمقايضة خصومهم بحريتهم مقابل إخماد صوتهم وإذعانهم لإرادتهم، وإلا فالسجن والتشويه مآلهم. ونتساءل بعد ذلك لماذا هذه الفوضى التي نعيشها في كل ركن من مجتمعنا؟ ولماذا هذا التسيب المخيف في القيام بالواجب؟، ولماذا هذا الانتشار الكاسح للغش في كل المستويات، عموديا وأفقيا، بكل مظاهره؟ ولماذا هذا التدني المفزع في القيم؟.. كلهم مسؤولون..كلهم مذنبون.. الفاعلون الرئيسيون والمشاركون والمتعاونون والصامتون.. فلا تخدعكم هذه المشاورات وتلك الوساطات وذلك التغني بالثورية، ذلك الاكتشاف المفاجيء الجديد بعد تسع سنوات من الاستغلال ومن أبشع ممارسات التضليل والترهيب والفساد والإفساد. وكأننا أمام فاعلين آخرين غير أولئك الأولين!
لو قارنتم بموضوعية بين مالَحِق البلاد والعباد من أضرار في سنوات حكم بن علي الثلاثة والعشرين وسنوات حكم حركة النهضة وحلفائها في التسع سنوات الأخيرة لأدركتم أنّ الفارق شاسع والبون كبير، والقادم أخطر، لو لم تُفيقوا، مع إني لم ولا أرى في أي العهدين ما كنت أُمَنِي النفس به، برغم مكاسب متفاوتة الأهمية فيهما، ومساويء ومضار كذلك. وإيمانا مني بالتنسيب وبالموضوعية في الحكم، أكرر من جديد أنني عرفت طاقات وطنية عالية الكفاءة في العهدين، تماما كما عشّش فيهما كثير من الانتهازيين! كان دائما أملي أن يأتي يوم تكون فيه الدولة مدنية مواطنية يكون للشعب فيها حقوق كاملة بين بناته وبنيه بالتساوي، وإنصاف وعدل بين أفراده وجهاته. ونماء وازدهار للدولة والوطن، في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والثقافية والفنية والرياضية.
دعكم من إحصائاتهم المغشوشة والمتلونة بحسب غاياتهم السياسوية، وخذوا طبشورة ولوحة أو حاسوبكم وافتحوا صفحة بيضاء، واكتبوا قائمة بثروات بلدنا، من زيت ولوز وتمور وفوسفاط وغاز وبترول، وما توفره من مداخيل، زيادة على مداخيل الضرائب القارة الإجبارية، من نوع معلوم جولان السيارات Vigniette، والأداء على القيمة المضافة وبقية الأداءات، هذا فضلا عن مداخيل النقل العمومي، سواء منه الحضري أومابين المدن، البري منه والحديدي، علاوة على الطيران. وضعوا أمامها عدد سكان بلدنا الذي بالكاد يناهز 11 مليون نسمة، حوالي مليون ونصف منهم يعيشون في المهجر، يرسل عدد كبير منهم مقادير شهرية من العملة الصعبة إلى أهاليهم، يستفيد منها البنك المركزي. وسترون أنّ محاسبيْن شريفيْن، رجلا وامرأة، وخبيريْن نزيهيْن في القانون، رجلا وامرأة أيضا، وديبلوماسييْن وطنييْن، رجلا وامرأة دائما، ومثقفيْن وطنييْن، رجلا وامرأة، وفنانيْن، رجلا وامرأة مشهود لهما بالكفاءة والوطنية طبعا، وعامليْن وطنييْن، رجلا وامرأة، لهما خبرة بالحياة السياسية، وصناعييْن اثنيْن، رجلا وامرأة وطنييْن، ورياضييْن نزيهيْن نظيفين، رجلا وامرأة، سيكونون، كلهم، ال16 شخصا، 8 نساء و8 رجال، أفضل حكومة ثورية بالمعنى الصحيح.
لاأقول هذا نفيا للأحزاب ولدورها السياسي، وإنّما أن تُراعَى الصفاتُ المذكورة في البحث عن الكفاءات في الأحزاب الوطنية التي قد تتشكل منها الحكومة. غير إنّ ذلك لن يكون سهل التنفيذ في ظل هذه المناورات والمساومات القائمة حاليا.. لذلك وعندها، لن يبقى أمام المواطنات والمواطنينإلا الدفاع عن مواطَنتهم، والتنظمُ في هيكل سياسي مواطني تكون له قيادة مصعدةٌ من الفروع تملك برنامجا دقيقا، وتكون غايتهم افتكاك دولتهم ممن اختطفوها، وإعلائها دولة مدنية مواطنية..وعندها، يتم إرساء المساواة الحقيقية التامة بين المواطنات والمواطنين، وحفظ كرامتهم بالفعل، ونشر ثقافة إنسانية تحتضن مختلف ثقافات الكون. هي دولة ترعى معتقدات وحرية ضمائر الناس، وتجعل القانون العادل فيصلا حازما بين المواطنات والمواطنين من أجل خير الوطن والمواطنين. في رحاب تلك الدولة يكون الشغل والمسكن والتداوي حقا متساويا للجميع وفي أحسن الظروف. وعندها فقط يُستأصل الفساد آليا ويعود للقيم ألقُها وتعود الطمأنينة إلى القلوب ويزول الخوف.. حقاً،كيفما تكون الدولة يكون المواطنون!
- اكتب تعليق
- تعليق









