الأسعد العياري : فــنّ التـأويـل ومــستـقبـل النّـص المـقــدّس
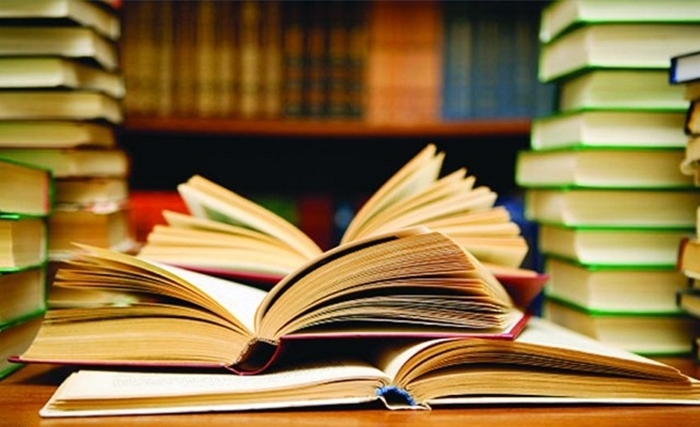
عندما جاءت المقاربات التأويليّة وطرقت أبواب المقدّس المنغلق على قداسته، جلبت معها نزعة عقلانيّة في مساءلة الدّين وقراءته بفكر نقديّ حرّ ومستقلّ عن التعصّب والتطرّف، يعني جدلا أن نفكّر في الدين لفهمه بجذور فلسفيّة تتعلّق بكيفيّة التفكير في معرفة الحقيقة، من خلال إلقاء السؤال التأويلي على السؤال الدّيني اللّاهوتي.
شكّل الركـــود الفكـــري الذي شهــــده العقــل الإنساني عامـــة والإسلامي خاصة إلى بدايات القرن التاسع عشـــر، دافعا قويّا لطــرح أسئلة ترتبط بفهـــم النصّ المقدس بعــد أن عجزت المناهج التفسيريّة القديمة والحديثة عن إنتاج إجابات منطقيّة عن القلق المتجدّد الذي يعيشه المؤمن مع نصّه المقدس لإشباع تطلّعاته المعرفيّة والدينيّة الدؤوبة، ولئن كان التأمّل أو النظر في تاريخ الفكر البشري يثبت أنّ ولادة النصوص الدينية قد رافقها على امتداد قرون عديدة من الزمن احتكار تفسيرها من قبل تيّارات وفرق إيديولوجيّة كانت تؤمن بأنّ هذه النصوص إنّما هي وسيلة من وسائل الهيمنة على الأفراد والشعوب وهو ما جعل هذه التفاسير موجّهة لخدمة مصالح سلطة سياسية تسعى إلى فرض سلطانها على الكلّ الاجتماعي المطالب بالرضوخ لا إلى سلطة النصّ وإنّما إلى سلطة تفسير النصّ. فالخلافة الأمويّة على سبيل المثال عندما تبنّت تفسيرات المرجئة اتخذت منها سلطة لخطاب معيّن في تفسير القرآن واعتبرته بمثابة الخطاب الرسمي الذي يرتقي إلى مصاف المعتقد وكلّ رأي يخالفه هو بالأساس تحريف للنصّ وافتراء على حقائقه، وقد ينتهي به المآل إلى التكفير والقتل. وفي السياق نفسه قامت قاعدة أوغسطين القديمة على أنّ سلطة الكتاب المقدّس هي أعلى من كلّ ما ينتجه العقل الإنساني، فكلّما حدث تناقض بين القاعدة العلميّة والحقيقة الموجودة بالكتاب المقدس، كلما اقتضى الأمر تغليب مقولات النصّ على حساب مقولات العلم، وهو ما أدّى إلى بروز حركات أصوليّة مسيّسة تقول «بعجز الإنسان عن تدبّر أمره في شؤون الدنيا دون التوجيه الإلهي». وأمام تنامي هذه النظريات الدينيّة بوصاية نابعة من تفسيرات أصوليّة للنّصوص المقدّسة اتّسعت دائرة القراءة لهذه النصوص فلم تعد مقتصرة على تحديد الواجبات من شعائر وعبادات بل تخطّت هذه القراءات حدودها الدينيّة لتشمل كل ما يتعلّق بالشؤون العامّة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، فاستحال مبدأ إقامة دولة إسلاميّة قاعدة مستخرجة من قراءات سياسية لنصّ القرآن وأحاديث السنة النبويّة ليرتقي إلى مرتبة الواجب الديني، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأحزاب اليهوديّة الأصولية في إسرائيل، نذكر منها على سبيل المثال أحزابا مثل «حريديم وغوش إيمونيم» اللذين لا يقفان عند عتبة تزويد إسرائيل بمشروعيات دينيّة مزعومة بل يذهبان إلى حدّ المطالبة بجعل النصوص الشرعيّة لديهم «هالاخالا» مثلا، أساس الدولة العبريّة بدعوى أنّ ذلك هو ما يمليه عليهم دينهم. أمّا التيارات المسيحيّة الممثّلة بصورة خاصّة باليمين الدّيني في الولايات المتحدّة الأمريكيّة فإنّها وإن لم تذهب إلى حدّ المناداة بإقامة دولة مسيحيّة، فهي مع ذلك لم تتورّع عن اعتبار الواجبات الدينيّة غير مقصورة على الشعائر والعبادات، بحيث نجد بعض القادة وزعماء هذه الحركات من يذهب إلى حدّ اعتبار العمل على إلغاء العجز في الميزانيّة الفيدراليّة للولايات المتحدّة الأمريكيّة واجبا دينيّا مستمدّا أساسا من قراءة وفهم مخصوص لبعض نصوص العهد الجديد.
انطلاقا ممّا تقدّم ونتيجة الفهم الذي انبنى على تفسير مخصوص للكتاب المقدّس والقرآن، ظهرت الحاجة الملّحة إلى التصدّي لهذه التفسيرات الدينيّة وبرزت العلوم الإنسانيّة كنسق فكريّ يقدر على خلق قراءات بديلة للنّص المقدّس تتواشج مع خصوصيّة الواقع وتتماهى مع أسئلة العصر، فكان التأويل ركنا من أركان تحديث الفهم الجديد لهذه النّصوص وتجديد الخطاب الدينيّ بأسئلة الحداثة.
الظاهـرة الدينيّة في ضوء العلوم الإنسانيّة
مثّل حلول القرن التاسع عشر مرحلة مفصليّة في تاريخ العلوم الإنسانيّة التي بدأت مع هذا التاريخ في التأسيس لذاتها باعتبارها علوما متمايزة عن العلوم الطبيعيّة، فحدّدت لمسارها أنساقا معرفيّة تمنحها القدرة على أنّ تقارب الظاهرة الإنسانيّة والاجتماعيّة من زاوية نظر موضوعيّة وضعيّة وعلميّة، ثمّ يتسّع نشاطها فيما بعد ليشمل موضوعات متّصلة بالاقتصاد والسياسة والاجتماع، وهو ما مكنّها من الانفتاح على تناول الظاهرة الدينيّة وإزاحة الاحتكار التقليديّ الذي ضربته علوم اللّاهوت على دراسة الدّين الذي ظلّ على امتداد العصور الوسطى حكرا على اللاّهوتيين في كافّة الأديان، وزعمهم في ذلك أنّ الدّين هو معطى مفارق لا يجوز إخضاعه للبحث العلميّ الذي تتعارض مناهجه وأدواته مع مسلّمات الاعتقاد، فكان اللّقاء بين العلوم الإنسانيّة والظاهرة الدينيّة، في بداياته، غير حميميّ إن لم نقل لقاء عدائيّا، إذ أنّ كلّ طرف كان يتوجّس خيفة من الآخر ويعتبره خطرا يهدّد سلامة وجوده. فالمقدّس كان يخشى من الإنسانيّات أن تسحب منه صفة القداسة التي اعتاد على احتكارها اللاّهوت وأهله، إذا ما تحوّل هذا المقدّس إلى موضوع للمساءلة الإنسانيّة التي ربّما تُفقده سلطة القداسة، وتستوجب مساءلة الكهنة والقساوسة ورجال الدّين والشيوخ والحاخامات وما في هذه المساءلة من تعرّض لسلطاتهم الممنوحة لهم من المؤسّسة الدينيّة. أمّا العلوم الإنسانيّة فكانت تخشى الوقوع خارج دائرة الفهم العميق للظاهرة الدينيّة المركبّة والمنقسمة قسمين رئيسيين؛ قسم عامّ مشترك بين الأفراد والجماعات بإمكان العلوم الإنسانيّة التعبير عنه ومعالجته بالدّراسة والتحليل المتعلّق بالعقائد والطقوس والتشريعات والاحتفالات الدينيّة والأنظمة الأخلاقيّة، وقسم ذاتيّ روحانيّ يختصّ بالتجربة الباطنيّة الإيمانيّة للمؤمن الفرد المتديّن والتي قد تعجز العلوم الإنسانيّة عن الخوض فيها بأدوات العلميّة والموضوعيّة.
ومن هنا بدأت رهانات العلوم الإنسانيّة في الإمساك بالظاهرة الدينيّة من كلّ جوانبها المختلفة والتعمّق في فهم الدّين باعتباره تجربة إيمانيّة قابلة للتفكيك ومقاربة مستوياتها الظاهرة والخفيّة وباعتباره أيضا نصّا لسانيّا لغويّا يتحدّد وفقه وعي الفرد بالوجود الإنساني ووعيه بحتميّة الحقيقة المطلقة. فازدادت حاجة الإنسان للعلوم الإنسانيّة لمساعدته على فهم النّصوص الدينيّة ومضامينها الرمزيّة والإيحائيّة، من أجل الفوز بحسن البقاء، خاصّة وأنّ العلوم الإنسانيّة مفهوم مفرد بصيغة الجمع على حدّ عبارة «أدونيس» تتقاطع فيه كلّ الأبعاد الإنسانيّة التي محورها الإنسان وسلوكه تجاه ذاته وتجاه الآخرين على كافّة المستويات النفسيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة. ولكي لا يسقط الفكر الإنساني في فهم الدّين كنقيض للعلوم الإنسانيّة ولا يتواصل احتكاره من قبل رجال الدّين لأغراض غير دينيّة تحدّ من حريّة الإنسان ومن فاعليّة التوظيف العقلانيّ في مساءلة الظاهرة الدينيّة، جاءت المقاربات التأويلية لتنمية النزعة العقلانيّة في مساءلة الدّين وقراءته بفكر نقديّ حرّ ومستقلّ عن التعصّب والتطرّف. ولا شكّ في أنّ تفسير النّص المقدّس وقراءته نصّا سماويّا قد قام على مثل هذه الفرضيّات والأسس المعرفيّة المؤسّسة على معرفة الوجود والوحي والنبّوة؛ وهذه المنطلقات النظريّة في علاقتها بفهم النّص وتفسيره قد مثّلت أبرز مشاغل التفكير الفلسفي ، وهو تفكير انبنى أساسا على الاعتقاد بأنّ النّص المقدّس «توراة وإنجيل وقرآن» هو نصّ تاريخي تتكثّف فيه شواهد تاريخيّة عديدة تدلّ على أنّه كلام نطق به أنبياء تكلّموا بالنّيابة عن الله أو هم المتكلّمون مع الله. وإنّ كلّ كتاب سماويّ مقدّس لا يعبّر عن حقيقة العالم ولا يخبر عن تاريخ الكون وأحداثه وإنّما هو يتحدّث عن رؤية كلّ نبيّ صاحب كتاب سماويّ للعالم ويبيّن قراءته للأحداث وللتاريخ ..وخلاصة هذه الرّؤية هي أنّ «جميع الظواهر والحوادث إنّما هي أفعال الله». وبالتالي فإنّ التأمّل الفلسفي التأويلي في الكتاب المقدّس والقرآن يدعونا إلى إعادة النظر جذريّا في مفاهيم دينيّة من مثل الوحي والإلهام والنبّوة وذات الله وصفاته وعاقبة الإنسان ومصيره. وهذا الاعتقاد بوحدة الأديان السماويّة من شأنه أن يبرّر إخراج هذه الدّيانات من سياقاتها التاريخيّة ودلالاتها الثقافيّة ومن سياقات جدليّة السلطة والمعرفة. فهل كان لا بدّ من التأويلية لتصحيح مسار الفهم العقلانيّ لأديان سماويّة مؤسّسة على تصوّر واحد للوحي، والحال أنّ التاريخ يشهد على صراع بين الإسلام والمسيحيّة واليهوديّة يعود أصلا إلى نزاع حول تصحيح العقيدة وتعديل البداهة الإيمانيّة التي تنطلق منها الديانات السماويّة بتوجيهها نحو مسارها الإيمانيّ المزعوم بالصدقيّة؟
ثنائية الشكّ والإيمان
كيف يمكن للعلوم الإنسانية أن تُسهم في تحرير العقل الدّيني من سلطة الوصاية والعادات الّتي تكبّله وتحدّ من حريّته في إعادة النّظر والنّقد والتّفكير؟ وأين تكمن التّحدّيات والمعضلات الّتي تحُول دون تنوير الفكر الدّيني عامّة؟
للإجابة عن هذا السؤال لابدّ من الإشارة في البداية إلى أنّ العلوم الإنسانيّة أغلبها مؤسّس على السّؤال والشكّ والتجربة والاختبار والمنطق، وجميع هذه المرتكزات تجعل من العلوم الإنسانيّة فضاء حواريّا غير مُنغلق على أسئلة العصر وتحدّياته ورهاناته. ومن أوضح الشواهد دلالة على ذلك هو أنّ فن التأويل غير منفصل عن التطوّر الّذي يمكن أن يحصل للاّهوت والعقائد الدّينيّة بما أنّ الإصلاح الدّيني الّذي طرأ على العقيدة المسيحيّة قد انبثق أساسا من الثورة الهرمينوطيقيّة الّتي فجّرها مارتن لوثر وجان كالفن وأتباعهم. فكان لا بدّ من إعادة موضعة الدّين في سياقات أكاديميّة حديثة، ومراجعة النّصوص المقدّسة بأدوات تفكير جديدة ترصد التّجربة الدّينيّة، وتقوّم نتائجها وهو ما سمح لنظرية التأويل أن تتأسّس على ثنائيّة الشكّ والإيمان في تعاملها مع النّصّ الدّيني في سياق إشكاليّ يبحث في سؤال ماذا نقصد بالنّصّ؟ وماذا نقصد بالقراءة؟ يعني جدلا أنّ قراءة الرّجل لسفر التّكوين من العهد القديم يمكن أن تختلف عن قراءة المرأة له، وهو ما يجعل قراءة النّص المقدس تأويليّا لا تبحث عن الإجابات الصّحيحة بقدر ما تبحث عن إرساء جسور الجدل والحوار والنّقاش مع هذا النّص: وهو أيضا ما يفسّر أنّ قراءة أحبار اليهود القدامى وفهمهم لنصّهم المقدّس يختلفان عن فهم المسلم أو المسيحي وقراءته لتوراة اليهود.
وبالتّالي اقتضت الحداثة بروز نقلة نوعيّة تستند إلى ممارسة العقل والتّعليل الإنساني في التّمييز بين تأويل الإيمان وتأويل الشّك، وقد تجلّى ذلك مع فريديريك شليرماخر الّذي ارتقى بفن التأويل وطوّره إلى مصاف العلم ليضعه ويلهام ديلتاي فيما بعد في سياق العلوم الاجتماعيّة بعد أن تمّت علمنته.. فتغيّر بذلك اللّاهوت المسيحيّ واللاهوت اليهودي متأثّرا بالمنهج التأويلي وبتبدّل أطر التفكير العلمي، وهو ما أسهم في ظهور تيّارات فكريّة جديدة تراوح بين إدماج الفلسفة الوجوديّة مع التاويلية في مشروع رودولف بلتمان القائم على نزع الأسطورة من النّصوص الدينيّة وبين المشروع الهيدغيري الذي نادى فيه صاحبه إلى إعادة إقحام اللّاهوت في البحث عن سؤال الوجود من خلال التوسّل بأسئلة الهرمينوطيقا وفن التاويل، أو من خلال العودة إلى القضايا الأساسيّة في التفسير المسيحيّ للإنجيل ضمن هرمينوطيقا بول ريكور المعاصرة، وبذلك فإنّ إصلاح الفكر الدينيّ يظلّ محكوما بالحركة العلميّة لإنتاج معرفة خالية من كلّ إمكانات السقوط في الذاتيّة والإيديولوجيّة. ولئن ساعدت العلوم الإنسانيّة في الفضاء الأوروبي على فهم الخطاب الدينيّ المسيحيّ واليهوديّ وأخضعته للمساءلة النقديّة والعقليّة رغم العوائق المنهجيّة والابستيمولوجيّة، فإنّ العلوم الإنسانيّة في فهم الفكر الدّيني الإسلامي مازالت تبحث عن مشروعيّة إعادة النظر في طرق وأدوات قراءة النّص القرآني وتأويله بالاستفادة من منجزات المناهج النقديّة الحديثة، بالرّغم من أنّ ذلك يطرح إشكالا حيويّا قد يحوّل البحث في تأويل النص المقدّس إلى دراسة العلاقة الجدليّة بين المقدّس وإيديولوجيا البقاء.
الأسعد العياري
باحث جامعي
- اكتب تعليق
- تعليق








