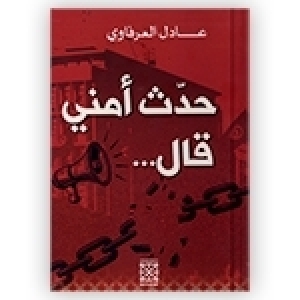منجي الزيدي: أنا أستهلك إذن أنا موجود...

يشتكي الناس من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ولكنّك تراهم يسرفون في اقتناء المنتجات، الضروري منها والكمالي، ويتنافسون في اتِّبَاع مستجدات الموضة في كلّ مجالات الحياة، كما تراهم يُكلِّفون أنفسهم ما يفوق طاقتهم لتلبية رغبات وشهوات لا تنتهي، ويتكبّدون في سبيل ذلك مشاقّ التداين والاقتراض والتقسيط المرهق ماديا ومعنويا. ولم تنجح في مقاومة هذا السلوك حملات التوعية بترشيد الاستهلاك ولا الدعوات إلى مقاطعة السلع التي تفوق أسعارها الحدّ المعقول.
مثال ذلك ما يتّسم به شهر رمضان من مبالغة في الاستهلاك حدّ التبذير أحيانا، رغم أنّ هذا الشهر في الأصل هو شهر جهاد النفس وكبح جماح شهواتها. حتّى إنّه ليخيّل لنا أنّ كثيرا من الناس يصومون بالنهار للأكل والشرب أضعافا مضاعفة بالليل، الشيء الذي جعل الحكومات تتجنّد لضمان وفرة المنتجات وتنوّعها وهي تعتبر نجاحها في ذلك إنجازا كبيرا.
أنّنا نعيش في مجتمع الاستهلاك. وهذا المصطلح معروف في الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية. وهو من المفاهيم الأساسية التي استعملها الباحثون والمفكّرون في قضايا النظام الرأسمالي وآليات اشتغاله. هذا النظام يقوم على هدف رئيسي هو تحقيق المزيد من الأرباح من خلال الاستهلاك المستمر والمتزايد؛ وذلك شرط من شروط تجدد الرأسمالية واستمراريتها.
يتعلّق الأمر بثقافة تعتبر الإنسان كائنا اقتصاديا Homo oeconomicus وبوجه من الوجوه كائنا شهوانيا. وتتعامل معه وفق منطق الحاجات المتجدّدة والرغبات التي لا تَشبَع و التي كلّما أُلقي فيها قالت هل من مزيد. إنّها سلسلة لا متناهية من الحاجات الاصطناعية التي تفرض نفسها كحاجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ويتمّ إشباعها بمنتجات متعدّدة الأنواع وسريعة الزوال تؤدّي بدورها إلى منتجات أخرى وهلمّ جرا. إنّه مبدأ لزوم ما لا يلزم المرتبط بمنطق الإنتاج للاستهلاك فالتبديد والإهدار فالإنتاج من جديد فالاستهلاك من جديد وهكذا دواليك...
وتنشط في هذا السياق الأذرع الإعلامية والترفيهية والإشهارية والتسويقية والخدمية، لتحيط بالإنسان وتحوّله إلى كتلة استهلاكية جماهيرية فتترصّد خطواته، وترصد رغباته وتوهمه بأنّه «الزبون الملك» وتقدّم له الحلول لمشاكله وتُصوِّر له واقعا «غير واقعي» تحكمه المتعة والسهولة والراحة والحرية...كما توهمه بأنّه ذكيّ فطن حسن التدبير يحسن اقتناص الفرص: يشتري منتجين ليربح الثالث مجانا، يقتني اليوم ليدفع بعد شهر، يسافر لأسبوع ليسدّد على مدار سنة، كلّما كانت الكميّة أكبر كان التوفير والادخار؛ وهكذا حتّى إذا ما فاقت الكمية الحاجة وقف «المستهلك الحاذق» يقلّب كفيه على ما أنفق فيها ثمّ يلقي بها في الزبالة؟!
من جانب آخر، تحوّل المنتَج الذي يقتنيه المستهلك من قيمة استعمالية إلى قيمة رمزية تبادلية. فلينظر الإنسان إلى طعامه وملبسه ومختلف الوسائل التي يستخدمها سيجدها أزياء وديكورات واكسسوارت لمشهدية اجتماعية كبرى. ذلك أنّ الحياة اليومية هي استعراض وتبادل للصور والرموز بين الأفراد. والمواد التي نستهلكها تمنحنا مكانة ووجاهة وتعكس هويتنا. ونحن نشعر بالراحة وتحقيق الذات عندما نكسب اعتراف الآخرين وموافقتهم والاشتراك معهم في نمط الاستهلاك.
ومن هنا تتغيّر محددات الانتماء من النطاق الاجتماعي إلى المجال الاستهلاكي. وتصبح الهوية الاستهلاكية من مقوّمات الاندماج الاجتماعي. ويمسي الفرد مواطنا في مجتمع المستهلكين يحمل إلى جانب بطاقة هويته المدنية بطاقة بنكية وبطاقة وفاء لمركز تجاري كبير (Carte de fidélité). والواقع أنّ الأمــر لا صلة له بقيمة الوفاء بقدر ما يعني تكريس الأَسر والتبعية لصناعة الرغبات. لقد اكتسبت صناعة الرغبات هذه قدرة عجيبة على التحكّم في الناس فاستسلموا لسطوتها طائعين. فهي تمتلك بلاغة في الإقناع بما لا يُقنِع وتبرير الشيء ونقيضه. إنّها تمارس نوعا من السلطة الناعمة التي تروّج مفاهيم جديدة عن السعادة والحرية والتعدّد. وهي تستهدف جسد الإنسان فتركّز على جوانبه «الليبيدينالية» وتستثني عقله. وتعتبر أنّ إرضاء هذا الجسد وإشباعه وإسعاده هو الهدف الأسمى. لم يعد الجسد عنوانا للعمل والكدّ والبذل والتضحية والزهد بل صار مطلبا استهلاكيا يخضع لقوالب وأنماط جاهزة هدفها ضمان المزيد من الإنفاق.

وما كان لمجتمع الاستهلاك أن يوطّد أركانه لو لم ينجح في تحجيم دور العقل والتفكير وتقليص الوعي، ونشر البساطة والاستسهال والميوعة، وتكريس الكسل الذهني والمعرفي؛ ولو لم تتخلّ وسائل الإعلام والاتصال عن دورها التربوي والتوعوي وتخضع لاستعمار الإعلانات ليحتلّ أوقات الذروة في بثها وينشر ما يشاء من الصور والرسائل ويكتسح الفضاء العامّ بخطاب دعائي يصوّر الاستهلاك كغاية للوجود البشري.
لقد كان المفكر الفرنسي «بودريار» على حقّ عندما بيّن أنّ مجتمع الاستهلاك يمتدح رعاياه فيوهمهم بأنّ لهم سلطانا مبينا فهم Powerful consumers، وهو في الواقع يحرص على أن تنحصر سلطتهم في مجال الاستهلاك فقط ولا تتجاوزه لتلج المجال الاجتماعي والسياسي.
لا غرابة إذن أن يصطفّ الناس في مشهد سريالي أمام المخابز قبل الإفطار وكأنّهم في يوم ذي مسغبة، وبعد ذلك يلقون ببقايا الخبز لتذهب غذاء للبقر والأغنام، وأن تنحصر قضاياهم في «فلفل» في غير فصله و»طماطم» لم تنضج بعد، والواقع يعجّ بمخاطر ما أنزل الله بها من سلطان.
منجي الزيدي
أستاذ تعليم عال بجامعة تونس
- اكتب تعليق
- تعليق