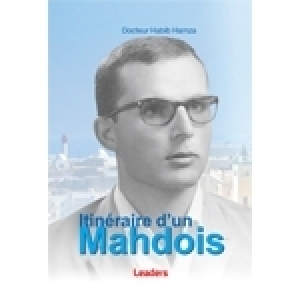حمادي صمّود، الإنسان والحرية
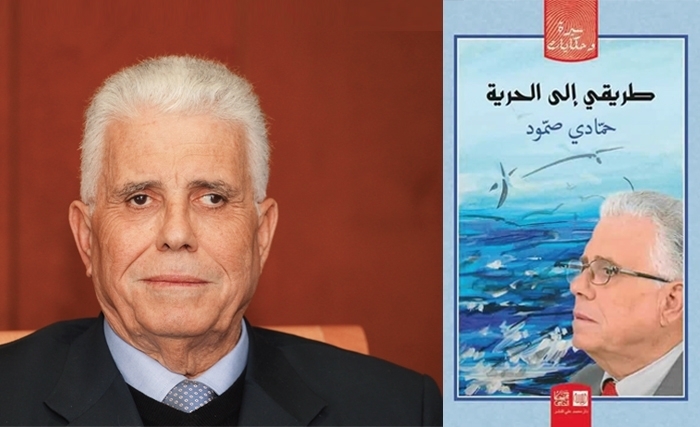
تضطلع المقدّمة في كتاب حمادي صمود «طريقي إلى الحرية» بالدّور الذي حدّده فيليب لوجون للميثاق في نظريته حول أدب السّيرة الذاتية، ففيها يعرض الكاتب أمام القارئ خطة العمل لتكون التزاما أدبيا بين الطرفين، وهو ينبّهنا منذ السّطور الأولى إلى أنّ هذا الكتاب وإن كان يستجيبُ في الظّاهر لشروط السّيرة الذّاتية ومقوّماتها فإنّه لم يُصنع ليكون القصُّ دائرا فيه على الذّات بل صُنع ليكون شهادة على مرحلة هامّة من تاريخ البلاد في ميدان التربية والتّعليم، وتحيّة إكبار واعتراف بالجميل لمن وجد الكاتب فيهم المثال والعون على الصّعوبات الجمّة في طريقه إلى الحرية، «وصُنع أولّا وأخيرا اعترافا لدولة الاستقلال بالجهد العظيم الذي بذلته لتعليم الأجيال».
.jpg) ولئن كان من المتعارف عليه لدى دارسي السيرة الذاتية أنّ الميثاق يُنتج آثاراً خاصّة على التلقّي فإنّ الإفلات من ضوابطه يدفع إلى ضروب من القراءة أكثر تحرّرا، فالقول بأنّ الكتاب شهادة على أعمال عظيمة في حقل التعليم واعتراف بجميل الرّواد لا يمثّل الاّ وجهة نظر واحدة وإن كانت وجهة نظر المؤلّف ذاته، والأصلُ في القراءة الحريّةُ وفي الأدب تعدّدُ الآفاق، لا سيّما أنّ الكاتب بذل جهدا كبيرا في المقدّمة لصرف أنظارنا عن الذّات كما لو كان يستبطن الاعتقاد السّائد بأنّ الحديث عنها أمر مُدان، فلطالما ردّد المنظّرون وجهة نظر البارونة «سطاف» في عرضها لقواعد فنّ العيش في 1889 واعتبارها الحديث عن الذّات دائما «موضوعا مزعجا ومملّا بالنسبة للآخرين»، وهذا الرأي قد يكون ذا جدوى في الحياة الاجتماعية، أمّا في أدب السّيرة فلا، إذ لا يتأسّس هذا الجنس الأدبي إلّا على استرجاع المؤلّف وقائع من حياته الشخصية، والسيرةُ في النظرية النّقدية «ليست نصّاً يقول فيه شخص ما حقيقة ذاته، بل هي نصٌّ قال فيه شخص واقعي ما قاله»، ولو أمسكنا بطرف الخيط هذا في كتاب حمّادي صمّود لقادنا إلى مناطق أخرى في النصّ يبدو من خلالها الكاتب أكثر من شاهد على العصر، وتنفتح لنا مسالك في القراءة تضفي على الأثر أبعادا أخرى، من هذه الأبعاد ما يتعلّق بالشكل الأدبي وبالسّارد في تردده بين الذات النصّية والشخص الواقعي.
ولئن كان من المتعارف عليه لدى دارسي السيرة الذاتية أنّ الميثاق يُنتج آثاراً خاصّة على التلقّي فإنّ الإفلات من ضوابطه يدفع إلى ضروب من القراءة أكثر تحرّرا، فالقول بأنّ الكتاب شهادة على أعمال عظيمة في حقل التعليم واعتراف بجميل الرّواد لا يمثّل الاّ وجهة نظر واحدة وإن كانت وجهة نظر المؤلّف ذاته، والأصلُ في القراءة الحريّةُ وفي الأدب تعدّدُ الآفاق، لا سيّما أنّ الكاتب بذل جهدا كبيرا في المقدّمة لصرف أنظارنا عن الذّات كما لو كان يستبطن الاعتقاد السّائد بأنّ الحديث عنها أمر مُدان، فلطالما ردّد المنظّرون وجهة نظر البارونة «سطاف» في عرضها لقواعد فنّ العيش في 1889 واعتبارها الحديث عن الذّات دائما «موضوعا مزعجا ومملّا بالنسبة للآخرين»، وهذا الرأي قد يكون ذا جدوى في الحياة الاجتماعية، أمّا في أدب السّيرة فلا، إذ لا يتأسّس هذا الجنس الأدبي إلّا على استرجاع المؤلّف وقائع من حياته الشخصية، والسيرةُ في النظرية النّقدية «ليست نصّاً يقول فيه شخص ما حقيقة ذاته، بل هي نصٌّ قال فيه شخص واقعي ما قاله»، ولو أمسكنا بطرف الخيط هذا في كتاب حمّادي صمّود لقادنا إلى مناطق أخرى في النصّ يبدو من خلالها الكاتب أكثر من شاهد على العصر، وتنفتح لنا مسالك في القراءة تضفي على الأثر أبعادا أخرى، من هذه الأبعاد ما يتعلّق بالشكل الأدبي وبالسّارد في تردده بين الذات النصّية والشخص الواقعي.
يبدو تفكير الكاتب مُنصبّا في المقدّمة الأولى على ما ينبغي أن ينتبه إليه القارئ أثناء التّلقي، بينما نجده في المقدمة الثانية وعنوانها «في انتظار الآتي» يكتب تفاصيل لحظة مهمّة في تاريخ الكتاب هي لحظة الإرهاص الأولى، لحظة الشروع في النص، في هذا التمهيد المكثّف تبدو الكتابة مواجهة مع الزمن، فالعنوان يحيل على المستقبل، لكن انتظار الآتي لم يبدأ الآن في ساعة الكتابة، بل بدأ منذ زمن بعيد «عندما تكون رغبتك العنيفة كتابا قضيت عمرك في ترقّبه»، أما اللحظة الفاصلة بين الرغبة والإنجاز فمحرّكها الخوف من الموت لأنّه يعادل الصّمت «وسكنك خوف من أن يَسْكُتَ الكتابُ فيكَ ويلفُّ الصّمتُ إذ يلفّكَ الموتُ حياةً لم تعصف بها لذةٌ كلذّة القولِ»، عندها يتساءل الكاتب عن «سرّ التمنع وبقاء رغبة الكتابة في الوهم». هذا النصّ الذي يُجمل فيه الكاتب بتركيز شديد دوافعه الذاتية لكتابة سيرته يمثّل جزءا من «الميثاق السيرذاتي» بل لعلّه أن يكون الجزءَ الأكثر أهمية، فإذا نظرت إليه بنيةً مغلقة وجدتَ أنّه مقدّمة مثالية وتقليدية للسيرة الذاتية من حيث هي تتويجٌ لتجربة ورغبةٌ في توثيق حياة زاخرة كتلك السّير التي يصفها «جورج ماي» بأنّها «محاولات يائسة للانتصار على الزمان والموت»، وما أشبه قول حمادي صمود «اللّغة باقية رغم الفناء وحانية في صمت متأهّب على ما استودعتها من حياة» بقول محمد شكري «قل كلمتك قبل أن تموت فستعرف حتما طريقها». لكنّك عندما تنظر إلى هذا النصّ في صلته بكاتبه، الشخص الواقعي الذي يضع اسمه وصورته على الغلاف سيبدو لك الأمر مختلفا جدا، فكتاب «طريقي إلى الحرية» إبداع أدبي فريد لرجل قضّى حياته كلّها في مجال الدرس الأكاديمي والبحوث اللغوية المعمّقة.
يقع ذلك في «موارد الصّفاء» الفصلِ الأوّل الذي خصّصه الكاتب لاستعراض مراحل من طفولته المبكّرة في قرية بحرية يعاني أهلها الضّنكَ وصعوبةَ العيش، ففي هذا الفصل تجاوز الكاتب شروط السيرة الضيقة وتقمّص روح الروائي ليكتب ثلاثة نصوص هي «في الإخبار عن موت «قبة» و«جْميِّل» غرقا»، «في الإخبار عن دهاء الرّايِس فْرجْ وإيقاعه برُيّاس في عقر دارهم»، و«في حادثة انقلاب «النّسْرِي» قبالة الطّنارة»، هذه النّصوص أقرب إلى القصص القصيرة منها إلى أيّ جنس آخر، ويمكن بلا تردّد نسبتها إلى «أدب البحر»، فالمؤلف لم يكتف فيها بسرد تفاصيل من حياته الشخصية إنّما صوّر حياة المجتمع في هذه القرية ومعاناة رجالها البحرَ طلبا للرزق، وهو ما جعله يخرج من غرفة السّيرة بواقعيتها الصارمة إلى ضرب من التخييل الروائي الحرّ، فيسرد أحداثا عاشها البحّارة في عرض البحر، ويستغرق في الوصف بأناقة ودقّة على غرار قوله «كان أحدُ البحّارة جالسًا في قِشّ المركب واضعًا يدَه على قفل السّفينة جهةَ الدفّة وعيناه تتأمّلان زرقةَ البحر الدّاكنةِ تحت السّفينة وذهنُه سارحٌ في مآل هذه السّرحةِ»، أو قوله «كانَ البَحْرُ أملسَ كأنّهُ صبُّ لجُينٍ أو ذوْبُ رصاصٍ على أديمٍ مُستوٍ وأشعّة الشّمس تنعكسُ على كلّ بقعةٍ لزِجةٍ أوْ مبلولةٍ لمعانا يتّقيه البحّارة بإمالةِ مِظلاّتِ رُؤوسِهمْ إلى الأمام لتَجنّب وقعِه على أبْصارِهِمْ». لقد صيغت هذه النصوص لتصّور أثر البيئة في تكوين شخصية صاحب السيرة وتبرز الدور الكبير الذي قامت به أسرته الصغيرة في سبيل تعليمه ووضعه على أوّل طريق الحرية حتّى بلغ منتهاه، لكنّها كانت أيضا فرصة سانحة لحمّادي صمّود الناقد والمفكّر اللغوي للظهور في مظهر القصّاص والروائي متحرّرا من أسر النظريات وإكراهاتها، ولمّا كان الكتاب كلّه إبداعا أدبيا يخترق الأجناس والحدود ندرك ممّا ورد في الميثاق توق الكاتب إلى أن يتوّج حياته العلمية الصارمة والمنضبطة بفعل إبداعي يجسّد الحرية في أسمى معانيها، فقد قال في وصف الكتاب: «ولم يأتِ والرّغبةُ عنيفةٌ مُلحّةٌ آيَستكَ من كلّ شيءٍ سواه، وعلّقَتْ به طُموحَك الأكبرَ وأقنعتكَ أنّ حياتكَ فراغٌ ما لم يملأها وعبثٌ إن لم يُكسبها معنى، وتَراءى كلُّ ما أنجزْتَ في انتظارِ أنْ يَأتِي لا أصلَ لهُ في قرارةِ ذاتِك».
أما في «مسالك الحيرة» و«أبواب مشرعة» فقد امتزج الاعتراف الذاتي بالنقد الموضوعي والتقرير التاريخي، وحرص الكاتب على أن يتعالى على ذاته الضيّقة كثيرا ليكون ملاحظا وناقدا وموثّقا، فكان في بعض التفاصيل أشبه بالكاميرا التي تنقل لأوّل مرّة وفي حدود المسموح به أخلاقيا ما كان يدور في الغرف المغلقة، كأن يصف ما حدث في اليوم الأوّل بالجامعة بعد أن انتدب للتدريس: «ما إن أنهى رئيس القسم العبارات المراسمية..ورحّب بالملتحقين بالقسم الجدد حتى تحوّلت القاعة إلى حلبة صراع تتسابق فيها أطراف في التشنيع على رئيس القسم والجرأة عليه بكلام سوقي وإشارات وحركات يخجل عتاة «البانْديّة» من إتيانها»، أو في اعترافه بأنّه ظلّ يعتقد أنّ المؤتمر الكبير الذي أسهم في تنظيمه مزّيتُه الكبرى «إخراج الاهتمام من الاختصاص إلى الجمهور العريض وتنبيه الأوساط الجامعية العربية بالنّقلة النوعية الهامّة التي حدثت في تونس في التعامل مع الظاهرة اللغوية»، ظلّ يعتقد ذلك إلى أن نبّهه أحد الأصدقاء إلى أنّ المؤتمر لم يكن خالصا للعلم، بل كان يهدف أيضا إلى إضعاف سلطة الأستاذ صالح القرمادي العلمية لأنّ السلطة السياسية تعتبره معارضا لا بدّ من أن تُخضد شوكتُه، ولا يخجل حمّادي صمّود في هذا السياق من الاعتراف بالسّذاجة قائلا عن القرمادي: «أرجو أن يبلغَه صوتي حيثُ هُو يرفع له اعتذاري عمّا ساهمتُ فيه وأنا خالي الذّهنِ منهُ»، وفي مواضع أخرى نجد ما يشبه أدب الرحلة لا سيما في الفقرة المطوّلة التي خصّصها الكاتب لسرد تفاصيل رحلة قام بها إلى اليابان مبعوثا من سلطة الإشراف لإعداد تقرير عن النهضة العلميّة في هذا البلد ورصد ما يمكن الإفادة منه لتطوير التجربة المحلية وهو ما لم يحدث مطلقا بعد أودع التقرير في أحد الأدراج ونُسي كأنْ لمْ يكن.
إنّ «طريقي إلى الحرية» ليس سيرة ذاتية فحسب وإن اكتملت فيه كلّ شروطها بل هو نصّ جامع يشمل صنوفا من القول مختلفة تجمع بين أدب الاعتراف والتخييل السردي، وهو في حياة الكاتب تتويج لمسيرة مُعلّم قطع على نفسه عهدا بالوفاء، ففي الفقرة التي وصف فيها فرحته يوم حصوله على منحة قومية لثلاث سنوات يقول: «هذا دينٌ لدولة الاستقلال لم أنسَهُ وحاولتُ عمري كلَّه أن أسدّده من موقعي بما أوتيتُ من جهد وقدرة، لم تثنني عنه الإغراءاتُ الكثيرةُ التي جاءتْ من جهات شتّى». والذين أتيح لهم الجلوس إلى الأستاذ حمّادي صمّود في قاعة الدرس يدركون أكثر من غيرهم أثر هذا الالتزام في أسلوبه وشخصيته العلمية والاجتماعية، فقد استطاع في وقت قصير بعد عودته من باريس مطلع الثمانينات أن يصنع لنفسه مكانة خاصّة ومميّزة لدى الطلبة، وصار مثالا في سعة الاطلاع والصرامة العلمية وقوّة الشخصية، وهي صفات جعلته بمثابة الأنموذج والقدوة لأجيال متعاقبة من مدّرسي اللغة والأدب. والسّيرة الذاتية تفسّر الآن هذا الجانب الذي تمتاز به شخصية الكاتب الواقعية في ضوء علاقته الوثيقة بمجتمعه، لكنّها تتجاوز ذلك لطرح مفهوم جديد للحرية في ضوء علاقتها الوثيقة بالالتزام..
عامر بوعزة
- اكتب تعليق
- تعليق